
الجاهلية بين المفهوم والواقع
نوري جاسم
قراءة في ضوء التاريخ والوعي الإنساني، فحين نسمع مصطلح «الجاهلية» تقفز إلى الذهن صورة قاتمة لعصرٍ غارق في الظلام، غابت عنه القيم، وتعلو فيه سطوة الجهل والتخلف والهمجية، لكن التأمل العميق في هذا المصطلح، وفهمه في ضوء النصوص والسياقات التاريخية، يكشف عن لبسٍ كبير وخطرٍ فكري وقع فيه الكثيرون، حين اختزلوا «الجاهلية» في زمن ما قبل الإسلام، وجعلوها وصمةً وعار لعصرٍ بأكمله، دون أن ينظروا إلى عمق ذلك المجتمع وتنوعه الأخلاقي والثقافي والإنساني، والجاهلية ليست زمناً بقدر ما هي وصف لحالة من الجهل القيمي، أو السلوك غير الأخلاقي، أو التكبر العنصري، أو الظلم، أو العصبية العمياء، وهي صفات قد تتلبّس أفرادًا في أي عصر، سواء قبل الإسلام أو بعده، بل حتى في عصرنا هذا، وربما بأشكال أكثر تعقيدًا وتستّرًا، فحين قال النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري «إنك امرؤ فيك جاهلية» لم يكن يخاطبه من خارج الإسلام، بل كان مؤمنًا صادقًا، ومع ذلك وصف فعله – حين قال لبلال: «يا ابن السوداء» – بأنه فعل جاهلي.
قيم ربانية
هذا القول النبوي الحكيم يفكك المعنى السائد للجاهلية ويعيد بناءه على أساس قيمي لا زمني، ويعلّمنا أن الجاهلية ليست مرحلة تاريخية انتهت، بل هي سلوك يمكن أن يتكرر متى ما غابت القيم الربانية والإنسانية،أما العرب قبل الإسلام، فلم يكونوا كما تُرسم لهم صورة نمطية باهتة، لقد امتاز الكثير منهم بصفات نبيلة، وقيم إنسانية عالية، مثل الكرم، والوفاء، والشجاعة، والنجدة، والمروءة، واحترام العهد، والذود عن العرض، بل وكانوا أهل فصاحة وبيان، تميزوا بلسان عربي مبين، نسجوا به شعرًا خالدًا حفظ لنا ذوقهم الرفيع ووجدانهم النبيل، وشــــــــــــــكّل ديوانًا للأمة فيـــــــــــــما بعد، المعلقات السبع – التي علقـــــــــــــوها على جدران الكعبة – لم تكن مجرد قصائد ترف أدبي، بل كانت شهادات حضارية على ما امتلكه ذلك المجتمع من حسّ جمالي، وبلاغة لسان، وعمق شعور، كيف نُسقط عن ذلك العصر هذه الكنوز ونستبدلها بوصمة الجهل المطلق؟
قراءة تاريخية
وكيف نُعمي أعيننا عن حِكَم زهير بن أبي سلمى، وأخلاق حاتم الطائي، وبلاغة قس بن ساعدة، وشهامة عبد المطلب، وغيرهم كثيرون من الذين مهّدوا بصفاء فطرتهم لطريق النبوة؟
إن وصف الجاهلية كمفهوم مطلق لعصرٍ سابق، لا يُجافي الحقيقة فقط، بل يُشوّه عدالة القراءة التاريخية. فحتى في عصر الإسلام، ظهرت مظاهر من الجاهلية.
في التصرفات أو السلوك أو النظرة إلى الآخر، وواجهها الإسلام بالتصحيح والتربية والتزكية.
لذلك، لا يصح أن نحصر الجاهلية في مرحلة ما قبل نزول الوحي، وكأنها كانت قوقعة مغلقة على الجهل وحده، بل الجاهلية قد تكون كامنة في أروقة السياسة، في عنصرية الشعوب، في تشجيع الإنسان، في الفساد، في خطاب الكراهية، في تهميش الضعفاء، وفي كل فعل يُقصي قيم العدل والرحمة والإنصاف، إننا اليوم، في القرن الحادي والعشرين، لا نعيش في الجاهلية الزمنية كما يقول بعض المؤرخين، لكنّ بعض تصرفاتنا ومواقفنا قد تكون جاهلية بامتياز، فحين نتفاخر بالأنساب ونحتقر الآخر المختلف، حين تُزهق الأرواح باسم العصبيات المقيتة، حين تهدر كرامة الإنسان باسم المصالح، فإننا نرتدي عباءة الجاهلية، وإن لبسنا أزياء الحداثة، ولذلك، فإن أعظم ما فعله الإسلام ليس فقط أن أنقذ الناس من جاهلية زمنية، بل أنه حرّرهم من جاهلية السلوك والفكر والانحراف، ووضع ميزانًا ثابتًا يقيس الإنسان بالتقوى لا بالعرق، وبالعمل لا بالنسب، وبالخلق لا بالقول، وإن واجبنا اليوم أن نعيد تعريف الجاهلية، فهي ليست مرحلة ماضية نحاكمها من علياء الزمن، بل هي مرآة نراجع فيها أنفسنا ومجتمعاتنا، لننقيها من شوائب الجهل المعاصر.
مرض قديم
ونستنطق من التاريخ حكمته لا أحكامه الجاهزة، فالجاهلية لا تموت بمجيء زمن جديد، بل تُهزم عندما تنتصر القيم، وتُبعث عندما تُدفن الضمائر، ولذلك، فإن القول بأن الجاهلية انتهت بانتهاء عصر ما قبل الإسلام هو تبسيط مخلّ وتحليل خاطىء جملة وتفصيلا، وإن وصم مرحلة بكاملها بأنها «جاهلية» دون تمييز بين ما فيها من ظلم وما فيها من قيم راقية، هو ظلم للتاريخ وللحقيقة، الجاهلية مرض قديم، لكنه يُصيب الأحياء في اي زمن وعصر وليس الأموات. وكل أمة تغفل عن ذلك، تفتح له الباب من جديد.
اللهم صل على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما .


 أكاديميون يدعون إلى إيجاد خطاب إعلامي يعزّز التفاهم بين الشعوب
أكاديميون يدعون إلى إيجاد خطاب إعلامي يعزّز التفاهم بين الشعوب
 الماركسية بين الفكر والأدب.. وآنعكاساتها على الرواية العالمية
الماركسية بين الفكر والأدب.. وآنعكاساتها على الرواية العالمية
 البارزاني يرحب بإتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
البارزاني يرحب بإتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا
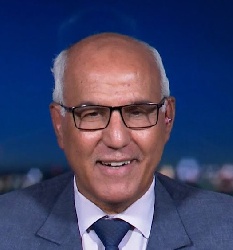 إسرائيل بين الأمن والأمان
إسرائيل بين الأمن والأمان
 غزة بين القتل جوعًا والحسم العسكري
غزة بين القتل جوعًا والحسم العسكري
 ريم الجوفي شجرة الضوء تقدم ورشة التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي
ريم الجوفي شجرة الضوء تقدم ورشة التمييز بين المعلومة والمعرفة في عالم رقمي
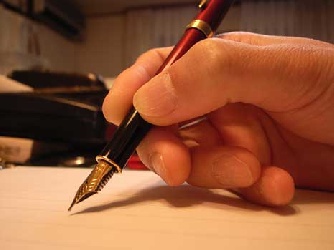 واقع البرامج السياسية بين التحييز والمهنية
واقع البرامج السياسية بين التحييز والمهنية
 إستعدادات لتنظيم مهرجان يستوحي (البينالي)
إستعدادات لتنظيم مهرجان يستوحي (البينالي)
