
أين مشروع اليسار العربي (1) ؟
عبد الحسين شعبان
تمهيد
حمل اليسار العربي منذ مطلع القرن العشرين، وبالتحديد بعد ربع القرن الأول منه، مشروعًا تاريخيًا أقرب إلى التكامل، فهو من جهة ظهر بالضد من الاستعمار والتبعيّة والتخلّف، ومن جهة أخرى حمل راية التحرّر والاستقلال والعدالة الاجتماعية.
وانصهر فيه ما هو وطني بما هو اجتماعي، حيث اندفعت النخب من الطبقة الوسطى لترفع مشروع اليسار وأحلامه الكبيرة إلى درجة امتزاج الواقع بالمخيال الشعبي أحيانًا، في إطار سردية ثقافية وآمال عظيمة ووعود ضخمة.
لكن هذا المشروع الكبير تعرّض إلى التراجع والانكسار لاحقًا، وخصوصًا بعد مرحلة الاستقلال، ليس بفعل ما لحقه من تنكيل وبطش وتحريم وتجريم، بل بفعل عوامل داخلية أيضًا، وليس بفعل العامل الخارجي وحده. ويعود جزء منها إلى الاتكالية الفكريّة والتعويل على ما يصدر من المركز الأممي، وأحيانًا أخرى إلى الجمود العقائدي والنصوصية المدرسية وعدم مواكبة التطوّر، وليس بعيدًا عن ذلك بعض المواقف ذات الطفولة اليسارية، لاسيّما الموقف من الدين والقضيّة القومية، فيما يتعلّق بفلسطين والوحدة العربية، وهو ما حاول خصومه وأعداءه تضخيمه وإلصاق تهم شتّى به بهدف النيل منه.أستطيع القول أن مشروع اليسار العربي توقّف عند الشعارات الكبرى التي كانت تصلح لمرحلة معيّنة، ولم يتمكّن من قراءة الواقع الجديد الذي ظهر بعد مرحلة الاستقلال وما أعقبها، الأمر الذي جعله يتأرجح بين خيارين كل منهما كان مرًّا؛
الأول - الانخراط في مشاريع سلطوية لم تمنحه الحد الأدنى من حريّة العمل والتنظيم حتى لو كان لتأييدها.
والثاني - الابتعاد عنها لدرجة الانغلاق والتقوقع في انعزالية وانطواء، دون التمكّن من تقديم بديل عمّا هو قائم، وتسبّب ذلك في اتّساع الهوّة بينه وبين الجمهور وبينه وبين الكتل البشرية التي يزعم تمثيلها.
وبعد انهيار الاتحاد السوفياتي تعمّقت هذه العزلة، حتى أن الأنظمة لم تعد تُعير اهتمامًا له، كما أنه خرج من معادلة الناس وهمومهم ومعاناتهم وتطلّعاتهم.
اليسار والربيع العربي
مع انتفاضات ما سميّ بالربيع العربي العام 2011، انفتح الفضاء العام أمام مطالب الحريّة والعدالة والكرامة، لكنّ اليسار لم يكن في صلبها لا في اللغة ولا في الأدوات ولا في التعبير ولا في المسار، وبالطبع فإنه لم يستطع أن يقرأ على نحو سليم مآلات الصراع، وازداد تأرجحًا بين التشكيك بحركة التغيير، بل واتهامها أحيانًا أنها من صنع الخارج، على الرغم من الملاحظات السلبية العديدة التي عليها، وبين النظر إلى السلطات القائمة بمنظار قديم باعتبارها معادية للإمبريالية، أو أن الإطاحة بها سيؤدّي إلى صعود قوى لا يُؤتمن إليها.
وبالطبع فإن الانتقاضات الجديدة لم تخضع للنمط الكلاسيكي للانتفاضات السابقة، فلم يكن لها قيادات مسبقة وأيديولوجيات محدّدة وسرديات معروفة، مع أنها خلقت فراغًا لم يتمكّن اليسار من إملائه كليًا أو جزئيًا، ناهيك عن التحرّك الفعلي، وذلك لأن أزمته عميقة وبنيوية في الآن، أي أنها لم تكن عرضيّة، بل كانت أزمة في الفكر والممارسة والتنظيم والقيادة والإدارة تعتّقت مع مرور الأيام.
وقد ظهرت بعض التململات اليسارية، لكنها كانت مختلفة عن اليسار التقليدي المعروف، فهذا اليسار الجديد هو يسار بلا تنظيم حزبي، وبلا أيديولوجيات مغلقة. يسار في إطار المجتمع المدني، وإن كان الأخير هلاميًا ومخترقًا في الكثير من الأحيان، لكن ثمة مبادرات اجتماعية ومطالب شعبية عامة وحركات نسويّة اشتغلت في هامش حركة التغيير بوسائل تكنولوجية ورقمية حديثة بعيدة عن تجارب الماضي، مستفيدةً من كون العالم يمرّ في الطور الرابع من الثورة الصناعية واقتصادات المعرفة والذكاء الاصطناعي.
اليسار الجديد ظل هو الآخر هامشيًا، فهو يسار معولم وفرداني، يتحدث بلغة البيئة أو المناخ أو الجندر، وإن كان يعبّر عن بعض التطلّعات العامة، لكنه كان بعيدًا عن الناس والفئات الكادحة، وبالتالي يصعب أن يتحوّل إلى قوة فاعلة ومؤثّرة، أي قوّة اقتراح يُحسب لها حساب. ومثل هذا اليسار سرعان ما تمّ تدجين الكثير من فاعليته واحتوائه، وبالتالي سيكون من الصعب أن يقدّم بديلًا مناسبًا.
مشروع تنوير وحداثة
انطلق اليسار العربي في مرحلته الأولى من مواجهة محمومة مع الاستعمار، وكان بمثابة مشروع تنوير وحداثة وتحرّر. صحيح أنه لم يتحوّل إلى تيار عريض باستثناء اليسار العراقي واليسار السوداني، لكنه لم يصبح حركة اجتماعية واسعة وجامعة، بل ظلّ يمثّل طموحات نخب مثقفة من الطبقة الوسطى صاغت خطابًا معتدلًا في إطار الدولة بمراعاة الفئات الفقيرة، وتلك إحدى ميزات اليسار التي افتقدها لاحقًا.
وقد تجسد مثل هذا التوجّه في التأثير على أطراف أخرى، ويمكن هنا احتساب بعض التجارب العروبية عليه أو بحكم تأثيراته عليها مثل اليسار الناصري واليسار البعثي السوري والعراقي واليسار الجزائري واليمني والسوداني والفلسطيني والليبي الذي صاغ شعارات راديكالية مثل التحرّر من الاستعمار وإجلاء القواعد العسكرية وإقامة العلاقات مع المعسكر الاشتراكي والتوجه نحو التعليم المجاني والإصلاح الزراعي والـتأميم، وكل هذه المشاريع حملتها أجهزة الدولة ما بعد مرحلة الاستقلال، وهي وإن أحدثت نموًا اقتصاديًا، لكنها لم تستطع أن تحقّق التنمية الإنسانية المستدامة والشاملة، لذلك ظّلت فوقية وسرعان ما تبخّرت.
اليسار والدولة
ظل مشروع اليسار مرتبطًا بالدولة، ولم يستطع أن يتجاوز أجهزتها البيروقراطية والأمنية. وهو ما غرق به اليسار الماركسي في تجارب الأصل في الدول الاشتراكية السابقة، وإن كان من ضحاياه في تجارب الفرع (حركة التحرّر الوطني)، علمًا بأن الدولة العربية كانت في الغالب دولة القمع والريع، وظلت المسألة التناوبية والتداولية في السلطة غائبة، والديمقراطية السياسية مؤجلة أو مرتهنة، بزعم أن العدو الإسرائيلي يدقّ على الأبواب، وبالتالي تمّت مقايضة التنمية بالعسكرة، ومقايضة الإصلاح بالتفرّد بالسلطة، وهكذا ضاعت فرصًا تنموية مهمة، مثلما قضم العدو الأرض بالتدرّج وعلى مراحل، وصولًا إلى مأساة غزّة.
منذ أواسط سبعينيات القرن الماضي انهارت الدولة التنموية مع أزمة النفط العام 1973، وتراجع الريع التنموي، وحين حلّت الثمانينيات لم يتبقّ من الوعود بالعدالة الاجتماعية سوى اللّافتات المهلهلة، ودخلنا في حروب ونزاعات إقليمية وأهلية، وتوسعّت طموحات البعض بفرض الهيمنة، فسوريا استحوذت على لبنان، والعراق غزا الكويت بعد حرب ضروس مع إيران دامت 8 سنوات، ونسى هذا اليسار القومي تحرير فلسطين وانشغل بحبك الدسائس والمؤامرات ضدّ بعضه البعض وإزاء الدول العربية الأخرى، وهذه الدول الأخرى لم تقصّر هي كذلك في السعي للإطاحة به وتبهيت شعاراته، وما زاد في انهيار اليسار تراجع الطبقة الوسطى وتهميشها لصالح بيروقراطية الدولة.
إضافة إلى تفكّك الكتلة الاشتراكية بعد انهيار جدار برلين في 9 تشرين الثاني / نوفمبر 1989. وأصبحت لغة اليسار، في معالجة الإشكاليات القديمة – الجديدة، أقرب إلى لغة أرستقراطية سياسية لا يصغي إليها أحد، لأن إداراتها تمارس السياسة كوظيفة وليس كفعل تغيير.
وتحوّل فريق من الماركسيين والشيوعيين إلى مجرد محلّلين سياسيين لإصدار تنظيرات لواقع متغيّر، لكنهم ظلوا متشبّثين بسردية مغلقة عن صراع الطبقات وإلغاء الاستغلال، في حين كان هناك فريق آخر يبشّر بالليبرالية الجديدة واقتصاد السوق، ولا يتورّع أحيانًا عن تبرير بعض ما تقوم به الدوائر الإمبريالية من احتلال وغزو بزعم تشييد صروح الديمقراطية، في الوقت الذي كانت الحركات الإسلامية تتمدّد مستغلةّ انهيار اليسار القومي، ولا سيّما بعد هزيمة العام 1967، التي قوضت شرعيته، وفشل اليسار الماركسي، فضلّا عن نجاح الثورة الإيرانية العام 1979، وانتشار الجمعيات الخيرية التي شكّلت دعائم اجتماعية فعّاله لتغلغل التيار الإسلامي.
مفكّر وأكاديمي عربي


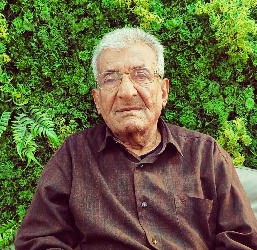 باحثة تستكشف مشروع طريق التنمية العراقي
باحثة تستكشف مشروع طريق التنمية العراقي
 الإعمار: إنجاز 80 بالمئة من مشروع ماء البصرة الكبير
الإعمار: إنجاز 80 بالمئة من مشروع ماء البصرة الكبير
 المبرّقع يثمّن جهود الملاكات والشركة المنفذة لمشروع ملعب المسيب
المبرّقع يثمّن جهود الملاكات والشركة المنفذة لمشروع ملعب المسيب
 هارف ينال تكريم الملتقى العربي لفنون العرائس
هارف ينال تكريم الملتقى العربي لفنون العرائس
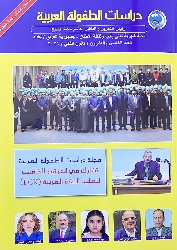 دراسات الطفولة تطرح رؤى فكرية للحفاظ على اللغة العربية
دراسات الطفولة تطرح رؤى فكرية للحفاظ على اللغة العربية
 التعليم يحتفي بإطلاق مشروع الحوكمة الرقمية الشاملة
التعليم يحتفي بإطلاق مشروع الحوكمة الرقمية الشاملة
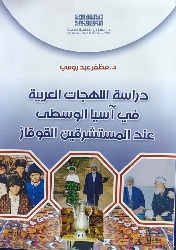 دراسة اللهجات العربية في آسيا الوسطى عند المستشرقين القوقاز
دراسة اللهجات العربية في آسيا الوسطى عند المستشرقين القوقاز
 إنطلاق مشروع المترو المعلق الطائر للمرة الاولى في الشرق الأوسط
إنطلاق مشروع المترو المعلق الطائر للمرة الاولى في الشرق الأوسط
