

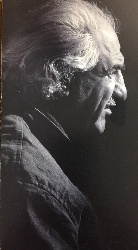


شاعرالضــــوّء والظِلْ.. شعرية صورة الفنان فؤاد شاكر
جاسم عاصي
الاحتماء بالظِل هروباً من الوقد ، والاستدلال بالضوء بحثاً عن الحقيقة . سمتان لن تفارقا صورة الفنان ( فؤاد شاكر ) فهي مراقبة دائمة ، لما هو حول الآخرين ، مقتربة أكثر لكي تُحيط بالفنان ذي الحساسية المرهفة إزاء المشاهِد ، لقد بقي الظِل حزام الباحث عن لذة الوجود والجدار الذي يحتمي خلفه ، وهو الغطاء الدائم للجسد ، ذلك لأن الفنان ينشط أمام ما يرى ويبحث في أزقة بغداد وحواريها ، لكي يقترب من نبض الحياة ، متسقطاً دقائقها التي تُقاس بالأنفاس، والضوء يمتد أمامه دليلاً للتائه في الزحمة التي حلَّ فيها ، فامتلكته على غير حسابها النمطي . يدخل المكان الجميع ، لكن الفنان له طقوسه حين يدخل ، فكل قطعة من جدار وباب في أزقة بغداد تعرفه ، لأنه يذكرها بسرها الموروث . فكلما اقترب منها هلّت في وجهه ، وتبرجت لا تبرج الجاهلية الأولى ، وإنما بقدر سرائرها الذاتية ، فهي عروس المكان الشعبي ، يستقرئ ما ضمُر في باطنه . ويرى ما بداخل زوايا البيوت دون أن يدخلها ، لأنه مراراً صوّرها ، ومراراً تطلع في أشكالها ، جدران وشناشيل ، وستائر وزخرفات أبوابها ومدّقاتها النحاسية ، مقاهي الحارّة وروادها من المتعبين ، الذين ألفوه وهو يحمل كاميرته على كتفه ، فلا يزدحمون عليه لالتقاط صورة ، لأنهم يعرفون ؛ أن فؤاد لم يأت إلا من أجلهم ، فهو سارد لحكاياتهم ، المليئة بالأوجاع مدوّن لآلامهم . لا يشكوه وجعهم وحرمانهم ، بل يجدوه يترجمها من خلال الصوّر ، فتطمئن قلوبهم . يطمئنها فؤاد بحسّه المرهف ، وشعره الإنساني وهو يمارس حرفته المغلّفة بالموهبة . فهو موهوب في اقتناص اللقطة ، ومرهف في اكتشاف مؤثراتها ، العارف بالكيفية التي تُسهم في بلورة الرؤى المكينة في تحقيق بنية جمالية لصورته . ولعل حكمة الظهور والاختفاء خلقت له نمطاً من فلسفة ، تمارس حراكها كلما ابتدأ الرحيل . فلسفته تنشط كلما اقترب من الضوء ، فيتحقق جدل العلاقة في الاختيار . لأنه يهرب من تأثير الكُتل الأسمنتية والمجالات المقفلة نزوعاً نحو فضاء أوسع ، بحثاً عن حرية صورته. كان مثل هذا التشوف يلازمه ، فيبدو كشاعر هيمان في الأمكنة يبحث عن ملاذ شعري خالص ، ولا ندري لِمَ يندفع إلى المغادرة كلما عنّت له المشاعر الغامضة ، فتأخذه الأمكنة بين أذرعها .فهو شاعر الظِل والضوء والزقاق والجدار بكل مكوّناته . إنه والمكان صنوان لا يفترقان. غير أنه لا يكتفي بما يمنحه من قدرة على التخييل ، كما يفعل فعله عند الساردين ، أو من ذوي الغوايات الجميلة . بل كان مكانه ملازماً للمستجّد . لذا فقد لازم المغادرة والدخول كما النهر في جريانه، حالماً بالساحر من الأمكنة . ولعله لم يفكر بسحر المكان ، غير أن عينه الثالثة من يستنطق رغبته في الكشف . لازمت عينه عين الكاميرا ، وأودعتا معاً الحكم للعقل ، فكانت الرؤى والرؤيا أكثر نصاعة . صحيح أنه يترك للقطة مسارها الشعري ، لكنه اندفع بوعي الضرورة في التمييز والاختيار والبوح . أداته في الأداء الشعري العين السحرية التي أدهشته منذ الصبا ، يوم كان الأب يتركه بين يديّ صاحب الكاميرا الشمسية على الرصيف . وحتماً سحره المشهد بقداسته ودهشته ، فراح يستسلم لعين المصوراتي ، ولا يدري أنه سيدهش الطبيعة باختياراته في يوم ما ، ويسحر الرائيين بندرة لقطاته . يجلس أمام العين السحرية ، ويقطع أنفاسه كما قال له الأب ، خوفاً من أن تفشل المحاولة . وحين يصطف بالقرب من قامة الأب ، يبدو ضئيلاً لا يفكر بأنه سوف يكون قامة فنية في قابل الأزمنة ، تراوغه مثل هذه العين السحرية ، لكنه خضع للجنين الذي بدأ ينمو بداخله ، والذي يلّح في السؤال منذ بدء لحظة إدخال المصوّر يده ليبحث عن المجهول لديه ، وحين أخرجها ترك خرطوم القماش متهدلاً إلى أسفل الصندوق الصاجي ، فتح مجرّاً صغيراً من خاصرة الصندوق المكعب الشكل ، أخرج قصاصة مضببه ، لا يدري ما هي . الصقها على خشبة امتد عنقها ، وراح يداور حركات غامضة . كان كل ما يجري أمامه يدخل في باب الخيال والسحر ، وقامته لا تفتأ تنظمّ لقامة الأب . ولحظة فتح المصوّر المجّر تارة أخرى ، اتضح سحر الساحر ، وانكشف المستور . ورقة تقطر ماء ، وأصابعه ذات النهايات الملوّنة بالداكن ، كأنها تعرّضت للحرق ، وهي تحمل ورقة فيها مربعات تنطبع عليها ملامح وجهه . وابتدأ السؤال ، ما الذي أدخله إلى بطن الحوت ، من أودعه في حاضنة الصندوق ، فأنه لم يسمع بعد بقصة يونس والحوت والبحر . لكن أدهشه المشهد الذي تركز في السؤال : كيف دخلت بجسدي إلى الصندوق ؟ وكيف خرجت منه بورقة مندّاة ؟ هذه الأسئلة لازمته وكانت تدفعه للبحث عن مثل هذا السحر ، لا ليكون ساحراً ، بل عارفاً . ليت سر السحر لم يتكشف له . اتسعت الرؤيا ولم تضق عبارة الصورة . كانت اكتشافاته تنضوي في مجال الحرفة والإبداع . ففي الأولى عرف سر وسحر العين ، ووسعت رؤيته سحر عينه ، وفسحت المجال لعقله أن ينشط على حد رؤية ( مرلوبونتي ) للصورة والمصوِّر . وفي الثانية حرص على أن لا يُبدد نظراته سداً ، بل كان رائده التدقيق في ما يرى ويكتشف . وكان الظِل والضوء ، وبالتالي الأسود والأبيض أكثر بلاغة من لغة اللسان . اكتشف أن في الوجود بلاغات متعددة ، لذا راح يلاحق بلاغة الصورة ، والعمل على استدراج بلاغة عين الكاميرا . سحرته الأمكنة ( الشوارع ، الأرصفة ،المقاهي ، القابعون في اللامأوى ، النساء المتلهفات للمعيل ، القابعان في قعر التاريخ ، الشيوخ المهضومين في الوجود ، الشباب الضائع في خضم الفراغ ، الأشعة الساقطة على ظلال الجدران ووشمها ،الشجر والنخيل ، العمارات التي لا ينكسر ظِلها ، والبيوت الآيلة للسقوط ، لكنها تستقبل الشمس بوفرة ، فيستوطن مساماتها الحر وتحترق جوانبها وتحيلها إلى هياكل أشباح . ويطول صيفها على شتائها خوف السقوط تحت وطأة تساقط المطر ، عمال المسطر الذين ينتظرون باستمرار من ينادي عليهم ، لكنه تألم حين توالت أخبار استهداف الموت المجاني لهم . كأن لا أمكنة تضم حيوات غيرهم . ساحة الطيران غدت سجلاً للموت . وحمامات ( فائق حسن ) لاذت بقامات الرجال والنساء والصبية الذين أصبحوا أكثر قرباً من بعضهم . هالتهم الاهتزازات فأبوا أن يغادروا اللوحة ، ويستسلموا لقضاة الشر ، المتسربين من مدارسهم ، والممتهنين حِرَف الذل نماذجه الدائمين
هكذا اتسعت رؤيته من اتساع رؤية الأمكنة التي يدخلها كل يوم وهو في جولاته العفوية في مدينة بغداد ، غير أن الغربة ضاقت بفؤاد يوماً. ولم تطلقه العزلة عن فرن الوطن ، فعاد ، وعاش ، واكتوى كجمهور المبدعين ، الذين ينسلّون من بيننا . لم تطأ أقدامه الرصيف إلا ليكتشف فيه السحر الفطري ، ولم يراقب خيوط الشمس ، إلا لكونها تراوغ الظِل ، ولم تبهره صورة الرجل وهو ينفث دخان نرجيلته سوى كونه يراقب ما بداخله ، وحرص على اختيار اللقطة التي تُعبّر عن هذا السر الذاتي في النموذج . وكانت مراقبته للمتسوّل سواء في الشوارع أو المقاهي أو على قارعة الرصيف حيث المأوى إلا من أجل تسقط سر تاريخ الجماعات ، ليكتب تاريخهم ، يوثقه بالصورة . إنه مطمئن على أن للصورة الآن بلاغتها ومجالها الحيوي الذي عمل على تنميته ( مراد الداغستاني ، ناظم رمزي ) وتوالت الأجيال حتى غدت تتسع باتساع الرؤى والرؤيا( فؤاد شاكر ، عادل قاسم ، جاسم الزبيدي ، كفاح الأمين عبد علي مناحي ، علي طالب ، ناصر عسّاف ، صفاء ذياب ) توزعت في صورهم المشاهد واتحدت مركزّة على الإنسان في الوجود . وفؤاد لم نجده يوما وهو يفارق كاميرته ، ولا استقر به الحال في مكان واحد ، بل راح يبحث في الأمكنة . لكن السؤال الذي يراوده : ما الذي يحاول تصويره بعدسة كاميرته حين عاجله شبح الموت .. تألم ؟ فوجئ ؟ اندهش من قادم على بعد ؟ هل التقط له صورة ؟ هل خضع له ؟ لا أشك في هذا . فالقدر يصعب التحكم في عناصره المتبدلة . غير أنه مصّر على أن يُمسك بكامريته ويسقطا سوية في أي الأمكنة ، فكلها له ومنه ، ولم يتركها نهباً للموت . ولم يخضع لجبروت السقوط على الرصيف ، بل مات واقفاً كالأشجار ، أو كعمته النخلة الشامخة ، لأنه صانع تاريخ لها ، نثرت عليه الطبيعة أزهارها حين غادر الأسود والأبيض ، مكللاً بالألوان ، وبالتأكيد اندهش لعظمة كاميرته وسأل : كيف استطاعت أن تختزن كل هذه الألوان ؟ إنها مستحقاته من كل ما راقبه واكتشفت عناصره الجمالية
فؤاد شاكر ... الذي كلما نظرت إليه ، لا يتصدر رؤيتي سوى ( إليوشا ) دستويفسكي . أنه كان يشبهه في شبابه ، بقفطانه الأسود ، وياخته القصيرة المنشاة ، وشعر رأسه المنسرح على الجانبين . الآن وفي بداية المطاف ، كان الأب ( زوسيما ) إني لأرى المعادلة مقلوبة . فقد حضر الأب ليقر اعترافات الابن . لم يكن اعترافه لسيدنا الأب سوى عن تلك العلاقة التي جمعته مع الكاميرا ، فهي سيرته الفنية ، ولا سيرة له مع غيرها ، فلا ضير أن يسترسل في حضرته راهباً مجيداً ومثابراً في حضرة الصورة.
طوبى للمصورين المنسيين .
طوبى لفناني الصورة وهم يتلهفون لدراسة ما تركوه .
طوبى لنا جميعاً ، نحن الذين لا ننتظر سوى الأرصفة ومساحات الشوارع ، كيف نؤدي دورنا في المسرحية الطويلة هــذه . لا نسقط ، بل نتشبث بستارة المسرح واقفين إلى الأبــد.
ففؤاد شاعر الأسود والأبيض . أو نقل راهب الضوء والظِل . وقل ما شئت تماماً ، كما كنت أتصور منذ أن قرأت تصريح الفنان ( فؤاد شاكر ) وهو في ريعان شبابه ، وعلى الصفحة الأخيرة من صحيفة الجمهورية وهو يقول ما مفاده : إني أغادر المكعبات الحجرية ، غرف الأسمنت وصلابتة جدرانها الضاغطة على جسدي ، وأنزع نحو الفضاء والخلاء ، حيث لا يتحكم في الأشياء سوى الضوء والظِل . من هذا اجتمعت عندي صورتان ؛ الأولى فضاء التصريح الفني والفلسفي والثاني تماثل شكل الفنان مع شخصية ( إليوشا ) الابن النقي لعائلة ( كارامازوف ) في رواية (فيدور دستويفسكي / الأخوة كارامازوف ) كنت أنظر إلى وجه ( فؤاد ) في الصورة وأتذكر صورة (إليوشا ) وحسبي أنهما لشخص واحد . ومنذ تلك اللحظة وأنا أتشوق لرؤيته ، حتى حل عام 2000 فأودع عندي الصديق ( ناجح المعموري ) مجموعة صور فوتغرافية لـ ( فؤاد شاكر ) بعد عوته إلى العراق ،خوفاً من مصادرتها في دائرة الكَمارك . فكانت معي في حلّي وترحالي في حارات عمان . صور أطفال يلهون في أزقتنا المتربة ، يتطلعون إلى عين الكاميرا . وجوه التقطت صورهم بعفوية ، فكانت تلقائيتهم في التعامل مع اليومي أهم ما جسّد وظيفة الصورة . لكن الملفت لنظري صورة ألصقت على قطعة خشب بالأسود والأبيض . لم يبرز على سطحها وجه أو هيئة . ولازمتني مشاهدتها مراراً . كنت أقرّبها ، ولا افقه شيئاً منها . أبعدها فتظهر لي رؤى متعددة . مرة غضون لقطعة من جسد شيخ هرم ،أو وجه التقطت منه زاوية . وهكذا تعددت زوايا النظر . غير أني وبالصدفة نفسها ، عرفت أنها لقطة لجذع شجرة ضخمة معمرة . حاول الفنان أن يعبّر مجازاً وبالصورة عن هرم الكائنات . هكذا تُكتشف النوادر ، وبنفس الطريقة تزداد اللهفة لمعرفة الكثير عن هذا الفن . صحيح أني كنت ألتقي الفنان ( جاسم الزبيدي ) وأعي جمال صوره وبلاغتها . لكن جاسم كان يُزيد من بلاغة التراجيديا حين تسأله عن اللقطة . أذكر وبالأخص السؤال عن صور حرب وتشرد الكائنات المعذبة أثناء حرب ( صبرا وشاتيلا ) فما كان منه إلا أن بدأ يتصفح ويُتأت ويبكي ويغضب ، حتى نفد منه الصبر فصمت . كانت عيناه تتسعان ، وتغرقان في بحر الدموع حد الذبول والاسوداد . هكذا يكون الفنان المحترف لصيغة فنه . فكيف بالذي ينقل الواقع برمشة عين ، وتتكثف عنده المشاهد ، حتى تحين لذلك التراكم الكمي كي ينتج تراكم نوعي ( الصورة ) إنه عذاب دائم . كان تعاملي مع فؤاد من باب حسيّة اللقطة وندرتها . فأسوده وأبيضه ذي بلاغة متناهية ، ونظرته إلى الأشياء مكثفة وانتقائية . وهو القائل كيف يبحث المصوّر عن اللقطة النادرة ، وهذا السيل من المشاهد الحية يملأ الشوارع والساحات العراقية . ويعني زحمة الواقع بالصور البكر . لذا أرى أنه بتجواله الدائم في شوارع بغداد وأزقتها يشكّل صيرورة الفنان المصوِّر . فهو لم يفارق هذه المجالات حتى لحظة وداعه لها . وهذه بلاغة بحد ذاتها . إنها معادلة ربما كانت عفوية ، لكنها بليغة ودالّة . تجوّل دائم في ا[لأمكنة المشاعة ،وقطع للحياة داخل حاضنتها دليل جمالي ــ فلسفي خالصين . فشاعر الأسود والأبيض ، وراهب الظِل والضوء أبى أن يفارق منشأ معارفه الفنية . تماماً مثل ( إليوشا ) لم يختر سوى الدير ، ولم يحزن على أبيه ــ غير الطاهر ــ أكثر من حزنه على الأب ( زوسيما ) وهو يعترف أثناء احتضاره في حضرة الفتى الراهب . فلم تكن مثل هاتين الصورتين ، استسلام ( فؤاد ) لقدره في الشارع العام ، وتواتر معرفة ( إليوشا ) في حضرة الكنيسة وبين يديه أب يعترف . لكن ما يميّز ( فؤاد ) أنه اعترف بين يديّ نصب الحرية ، وسط مساحة الانعتاق والنزوع إلى الحياة الجديدة . بالتأكيد ملأ عينيه برموز النصب قبل محاولته تصويرها للمرة ألأخيرة ، أو خُيّل له ذلك . المهم كان لرحيله معنى يكمن في عشق الفنان للحرية ، واستقلالية زمانه الأسطوري. كان همه أن يحوّل كل ما يُشاهده إلى قطعة من حكايات أو أساطير . ينزع نحو براءة الأشياء والظواهر ، لكي يسبر ما تضمره الوجوه ، الهيئات ، النًصب ، مصادر الماء ، المرتفعات ، العُليّات، محترفي الأرصفة ، البيوت المهجورة ، المقاهي ، بل الزوايا منها ، تلك التي يشغلها الفقراء والمعوّزون . حشد من الرؤى كان يتعامل معها الفنان . فقدره دعاه أن يذهب إلى النائي ليجعله مألوفا ً . يقرّب البعيد ، ولا يُبعد القريب ، بل يؤصله بالتدوين الصوري . فكان أرشيفه عامراً ومسدداً لدينه اتجاه الحياة ، أو قل وجوده الإنساني . ثابر واجتهد كأقرانه ، حاول أن لا يخرج عنهم سوى برؤيته ، وأبقى امتداده الفني ضمن عائلة زخر بانجازاتها العراق . المصوّرون أكثر الذي تلازمهم الصراحة مع الواقع . وهم أكثر المواجهين والعاكسين مباشرة بالأشياء . فليس في أعمالهم سوى الحقيقة . إذ تكمن في شروحاتهم الصورية بلاغة نادرة في اختيار اللقطات ، ووضع اللمسات التي تعكس جوّانية الفنان الذي لا يتخلى عن هاجسه الذاتي ، بل يعمّقه بالنظرة الشعرية المتأتية من الندرة في الاختيار وضبط اللقطة . بلاغتهم نادرة لأنها ترتبط بالعفوية من الأفعال . لكنها الأكثر جدية ورهافة في التنفيذ . فؤاد شاكر شاعر الظِل والضوء بامتياز .


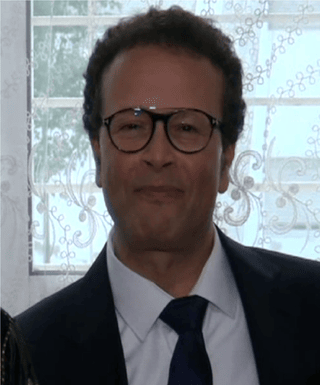 السيرة الذاتية الروائية المصورة.. التحديات والرهانات وضمانات النجاح
السيرة الذاتية الروائية المصورة.. التحديات والرهانات وضمانات النجاح
 مرسم الفنان.. تحليل من منظور سيكولوجي
مرسم الفنان.. تحليل من منظور سيكولوجي
 فوتوغرافيا الفنان عقيل غانم.. الصورة..من السكون إلى الحركــة
فوتوغرافيا الفنان عقيل غانم.. الصورة..من السكون إلى الحركــة
 نقطةُ ضوءٍ من التماعات بدر شاكر السيَّاب
نقطةُ ضوءٍ من التماعات بدر شاكر السيَّاب
 سيسيولوجيا الفوتوغراف.. الصورة بوصفها خطابًا اجتماعيًا وذاكرةً بصريةً للواقع
سيسيولوجيا الفوتوغراف.. الصورة بوصفها خطابًا اجتماعيًا وذاكرةً بصريةً للواقع
 متحف في السليمانية يستعيد 100 صورة أرشيفية عسكرية بريطانية
متحف في السليمانية يستعيد 100 صورة أرشيفية عسكرية بريطانية
 النظرة الشمولية لفن الصورة.. فوتوغرافيا الفنان ناصر عسّاف
النظرة الشمولية لفن الصورة.. فوتوغرافيا الفنان ناصر عسّاف
 صورة الرئيس المعتقة.. من يعزف البيانو لجياع الصومال
صورة الرئيس المعتقة.. من يعزف البيانو لجياع الصومال
