


تأملات في (الكتاب والقرآن) لمحمد شحرور
نوري جاسم
في فضاء الفكر الإسلامي الحديث، يُعد كتاب ( الكتاب والقرآن _ ط 1990 ) للدكتور محمد شحرور ( 1938 _ 2019 ) علامة فارقة، لا لأنه جاء بجديد فقط، بل لأنه فتح بابًا واسعًا للتساؤل، وهو من جملة من حرّك ساكنًا ظلّ جامدًا لعقود طويلة، هذا الكتاب ليس تفسيرًا تقليديًا للقرآن كما ألفه العلماء من قبل، وليس سردًا وعظيًا أو خطابًا تكراريًا، بل هو مشروع فكري متكامل، يحمل في طياته رؤية معاصرة تحاول أن تُعيد للقرآن معناه المفتوح، وتُخرجه من أسر الجمود الفقهي والمذهبي الذي طوّقه عبر التاريخ، يبدأ شحرور مشروعه من فرضية مركزية تقوم على إعادة النظر في المصطلحات القرآنية، وعلى رأسها التمييز بين "القرآن" و"الكتاب"، وهي نقطة محورية بنى عليها مجمل تصوره، فالقرآن عنده هو الجزء الذي يُتلى ويُتعبد به، بينما "الكتاب" هو منظومة الرسالة الكاملة التي تشمل القانون والمبادئ، والفرق بينهما في رأيه ليس لغويًا فقط بل وظيفي ومعرفي، وهذا التمييز الجريء سمح له بإعادة قراءة النصوص بعيدًا عن التقليد، ووضعه في موقع المراجعة النقدية الشاملة للتراث التفسيري، لقد أعاد ترتيب العلاقة بين النص الإلهي والقارئ الإنساني، معتبرًا أن الفهم التاريخي ليس مقدسًا، وأن الإنسان اليوم لا يقل أهلية عن من سبقه في تلقي النص وتدبره، بل هو مدعو لفعل ذلك ضمن أدوات العصر ومعارفه، وان أهم ما يميز هذا الكتاب أنه يُخاطب العقل بجرأة، ويُعيد له سلطته في ميدان الدين، لا ليعلو على الوحي، بل ليكون شريكًا في فهمه، شحرور لا يرفض النص القرآني، بل يرفض بعض التأويلات التي حولته إلى نص مغلق ومقيد بالسياق التاريخي والاجتماعي الذي ظهر فيه، إنه يدعو إلى قراءة القرآن قراءة مفتوحة، قائمة على أن النص يحمل طاقة متجددة لا تنضب، وأنه ليس حكرًا على طبقة فقهية أو سلطة دينية، إنه نداء لإعادة القرآن إلى ساحة الحياة، لا أن يُترك حبيس الرفوف أو المحاريب، ولعل في هذا الطرح تحريرًا للفكر الديني من الجمود، ودعوةً لأنسنة الرسالة، وتخليصها من البعد السلطوي الذي كُرّس باسم الدين لعصور طويلة، وعلى الرغم من القيمة الفكرية الكبيرة التي يحملها الكتاب، إلا أن القارئ المتأمل لا يسعه إلا أن يقف عند بعض المآخذ المنهجية، والتي لا تقل أهمية عن الإيجابيات. فشحرور في اندفاعه نحو العقلنة وقع أحيانًا في نوع من التفسير التعسفي للنصوص، خصوصًا عندما بالغ في استخدام الاشتقاقات اللغوية، وأعطى للكلمة الواحدة أكثر مما تطيقه دلالتها، وإن الاعتماد المفرط على الجذر اللغوي دون مراعاة لسياقات الاستعمال القرآني قد يؤدي إلى تحميل النص ما لم يُرِد، ويُنتج دلالات بعيدة عن السياق العام أو عن البنية البلاغية للنص، إضافة إلى ذلك، فإن مشروع شحرور، وإن كان تقدميًا في رؤيته للحقوق والحرية، إلا أنه تعامل مع السنة النبوية بتحفظ شديد، بل وبتقليص حاد لدورها، مما جعله يفصل بين النص القرآني والواقع التطبيقي الذي مثّلته النبوة، وهو انفصال قد لا يكون مُجدياً دائمًا في بناء رؤية متوازنة أو مكتملة للفكر الإسلامي،
ومما يُؤخذ عليه أيضًا أنه في سعيه لتجديد فهم النص وقع في نوع من القطيعة مع التراث، بحيث أصبحت العلاقة معه علاقة نقد وتجاوز لا علاقة حوار وتراكم، إذ أن إلغاء كل ما سبق لا يعني التجديد بقدر ما يعني بدء البناء من نقطة الصفر، وهذا قد لا يكون عمليًا أو مقبولًا في حقل فكر ديني متجذر، ان التجديد الحقيقي لا يكون بالقطيعة التامة، بل بالقراءة الواعية، لا بالتجاوز المتدرج ولا الصادم، ومع ذلك، فإن شحرور يُحسب له أنه تجرأ على الأسئلة الكبرى التي تهرب منها الكثيرون، وأن له دور في تشكيل العلاقة بين الدين والحداثة، بين النص والواقع، بين الثابت والمتحول. لقد فتح مجالات لفهم جديد لا يتعارض بالضرورة مع روح الدين، بل يستلهمها وينطلق منها نحو آفاق أرحب، وإن أطروحاته حول الحرية، والمساواة، والعقل، والعدل، والمرأة، والحدود، والدولة، والسيادة، كلها نابعة من قراءته للنص القرآني، مما يدل على أن النص لا يزال قادرًا على العطاء متى ما تمّ التعامل معه بعين العقل وصدق النية، ان كتاب ( الكتاب والقرآن ) ليس دعوة إلى الهدم، بل إلى التفكير. ليس دعوة إلى الإلحاد أو النفي، بل إلى الفهم العميق والواعي. هو كتاب صادم لمن تعود على التكرار، لكنه محفز لكل من يُحب أن يرى الدين حيًا في قلب العصر، متجددًا في شكله، ثابتًا في روحه. وإن كان البعض يرى فيه تجاوزًا أو خطورة، فإن الخطر الأكبر يكمن في الصمت والخمول والتقليد، لا في السؤال والبحث والاجتهاد. وبين الغلو في التقليد، والتهور في التفسير، يضع شحرور مشروعه في المنتصف، حيث يُمكن للعقل أن يشتغل، وللروح أن تهتدي، وللنص أن يُقرأ من جديد، وصلى الله على سيدنا محمد الوصف والوحي والرسالة والحكمة وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ..


 السوداني يثمّن دور الصابئة المندائيين في دعم التعايش
السوداني يثمّن دور الصابئة المندائيين في دعم التعايش
 هل ثمة أمل في الإنتخابات ؟
هل ثمة أمل في الإنتخابات ؟
 عن تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
عن تصفية الشركة العامة للتجهيزات الزراعية
 الاقتصاد الرقمي في العراق: آفاق واعدة وتحديات قائمة
الاقتصاد الرقمي في العراق: آفاق واعدة وتحديات قائمة
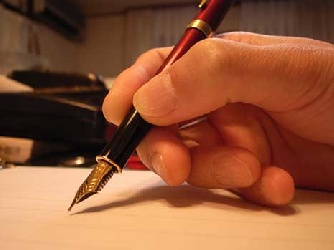 بوح العصافير الراحلة
بوح العصافير الراحلة
 كربلاء تنفرد بتوفير التنباك وسط دعوات لدعم إنتاج المحصول
كربلاء تنفرد بتوفير التنباك وسط دعوات لدعم إنتاج المحصول
 مفتن يستقبل قائد قوات الحدود ويشيد بدور الشرطة في دعم الرياضة
مفتن يستقبل قائد قوات الحدود ويشيد بدور الشرطة في دعم الرياضة
 لارا العميدي إنجازات وميداليات في فعاليات السباحة المحلية والدولية
لارا العميدي إنجازات وميداليات في فعاليات السباحة المحلية والدولية
