
المتن اللغوي الشَّعبيّ والمعتقد الديني نظرة في المنهج وإعادة التكوين.
كـريـم عـبيـد عـلـوي
ظاهرةُ التَّدين الشَّعبيّ ظاهرةٌ عكفت على دراستها منهجياتٌ عدة ، من أبرزها علم الأديان العام وعلم الأديان المقارن وعلم النفس الديني وانثروبولوجيا الدين وعلم الاجتماع الديني ، فهل يمكن للمناهج اللسانية أن تدلو بدلوها في هذا الميدان البحثي المهم ؟ وما الرؤية الجديدة التي يمكن أنْ يفرزَها النظرُ اللسانيّ ؟ وإذا كانت اللسانيات تختزن باراديمات مختلفة فما الباراديم المناسب للنظر في ظاهرة التَّدين الشَّعبي ؟ أهو النظر النسقي أم النَّظر الذهني التوليدي أم النَّظر التواصلي التخاطبي ؟ والتساؤل الثاني المهم : هل يمتلك التدين الشعبي متناً يُمكنُ أنْ يُشكلَ موضوعاً خاضعاً للفحص والتحليل والتفسير ويمكنه أنْ يُسعفَ بالعثور على بواعث التدين النفسية والاجتماعية التي تشكل بنًى عميقةً قابعةً في أغوار النُّصوص الشَّعبيَّة؟ وقبلَ هذا وذاك ما المقصود بالمتن اللغوي ؟ وكيف يمكنُ أنْ يكونَ للشعبي متناً لغوياً يضاهي المتنَ الرَّسميّ ؟
إنَّ المتن اللغوي في ضوء اللسانيات البنيوية هو مجموع الصور التعبيرية التي تكشف النسق العرفي الاجتماعي لنظام اللسان ، وهناك شروط ينبغي أن يتوافر عليها المتن اللغوي ، من أهمها أن يلبي سمة الشمول بمعنى أن يستوعب كل الظواهر والأنساق اللسانية الفرعية لنظام اللسان ، وأن يكون متجانساً لا يختلط فيه المستوى الأدبي مع المستوى التداولي الاجتماعي أو المستوى العلمي إذ ينبغي أن يتم تحديد المستوى إلى جنب سمة مهمة هي سمة التزامن بمعنى وحدة الزمان والمكان تحاشياً للنظر التعاقبي ، فاللغة متطور في مستواها التعاقبي الدايكروني عبر الزمن .
وتبرز صعوبة تحديد المتن الشعبي كون الشعبي هو يومي ويبتعد عن المستوى اللغوي المعياري والفصيح ، وهو شفاهي غير مدون موازنة بنصوص التدين الرسمي التي هي غالباً ما تمثل أعلى مستويات الانسجام في نسيجها البنيوي ومحتواها الدلالي ، وتمتلك فاعلية سلطوية تمنحها قوة تأثيرية إنجازية ناشئة عن فعل الإفتاء وخطاب الوعظ ، فالتدين الرسمي هو تدين مؤسساتي مما يمنح نصوصه اهتماماً في التدوين والتلقي والدراسة و تكتسب سلطتها من كونها نصوصاً شارحة ومفسرة للنصوص المقدسة .فهي المصدر الرئيس لدراسة التدين الرسميّ بينما تمثل الطقوس الدينية الشعبية والممارسات التعبدية العامة موضوعاً لفحص ظاهرة التدين الشعبي أكثر من النصوص اللغوية الشعبية ، ولعلَّ السببَ في ذلك لبروزها على السطح الاجتماعي بوصفها ظاهرةً قابلة للملاحظة والقياس وتصطبغ بالظروف الاجتماعية والبيئية للجماعات الشعبية التي تؤديها ، فالطقوس العبادية التي يفترض أنْ تكونَ واحدةً من منظور التدين الرسمي تختلفُ في الأداء بَيْنَ جَماعةٍ وأخرى ، فهي تتلونُ بفلكلور تلك الجماعة وتمتاح منه مما يشكل صلحاً شعبياً بين الفلكلور والتدين، و يكونُ الشَّعبيّ أكثر تسامحاً من الخطاب الدّينيّ الرّسميّ الذي يريد للعبادات وشعائرها أنْ تكون خالصةً من إضافات نوعية ، فهي واحدة وعابرة للزمان والثقافات المختلفة ، وهو يسم كلَّ إضافة بالبدعة والخروج عن جادة التشريع ويضعها في دائرة الحرام والإثم . لذلك فإن معظم الدراسات التي فحصت ظاهرة التدين الشعبي ترسم له صورة زاهية جميلة ومحببة ، فهو أكثر تسامحاً من التدين الرَّسمي وأقلُّ تزمتاً منه ويتصالح مع بيئته ولا يعمد إلى خطاب التأثيم ويضفي على العبادة جنبة تضامنية تعزز هويةَ الجماعة في جوٍّ من الألفة والحميمية تتجاوزُ فعلَ الامتثال والطاعة وصولاً إلى الشعور بالسرور والغبطة الجمعية إلى جنب تطهير الذات ، ولا يضيرها أنْ تقتبسَ بعضَ الملامح الشَّكليَّة من عاداتٍ دينيةٍ مختلفةٍ تنتمي إلى اعتقاداتٍ لدياناتٍ أخْرىْ .وعلى الرغم من ذلك إلا أَنَّ تلك الطقوس تخضع إلى مفهوم ِالمراقبةِ الاجتماعيَّةِ ، فهي طقوسٌ جمعيَّة ويبقى فيها الفردُ أسيرَ نظرةِ مجتمعهِ وهو ينخرط بتلك الطقوس فلا يتصرفُ بعفوية تعكس ذاته ، فـ (الأنا) في ضوء التصور الفرويدي سوف ترزح تحت سلطتين هما (الأنا العليا) و(الهو) المُرَاقَبُ من داخل الطقس الشَّعائريّ ، فالرياء والتصنع قد يحضرانِ فيه فلا يمكنُ أنْ يُطْمَأنَ دائماً إلى عفوية الطقسِ وصدقهِ وتعبيره ِعن رؤية التَّصور الشَّعبي على خلاف الخطاب اللغوي الفرديّ الشعبيّ ، فهو ذاتي وقد يفلت من قبضة المجموع ، ومنْ هنا تبرز الحاجة الملحة لدراسة المتن اللغوي الشعبي وضرورة فحصه. واذا كانت مناهج النقد الأدبيّ ونظريات السَّردِ هي أكثرُ فاعليةً من اللسانيات في فحص الخطاب الدينيّ وتفكيك ظاهرة التَّدين الشَّعبي لا سيما بعد شيوع دراساتٍ كثيرةٍ ترتكزُ على فحص المخيال الجمعيّ لرموز دينية مقدسة مبينة كيف تحصل الإزاحة بين ما هو بشري إلى ماهو أسطوري ومنسجم مع حاجات الروح الشعبية المتجددة إلى جنب اهتمام النقد الأدبي بدراسة الفلكلور .فإن مناهج اللسانيات نظراً لاهتمامها بنسقية اللسان بقيت بعيدةً عن الشَّعبي إلى أنْ برز حقل تحليل الخطاب ، فهو من الحقول البينية الذي يتيح لمنهجيات ونظريات متباعدة أن تتضافر في المعالجة لاسيما بعد أنْ احتضنت مناهج تحليل الخطاب ما يسميه (جان لوسيركل) في كتابه (عنف اللغة) بـ (المتبقي) أو المستبعد من المتن اللغوي الأدبي الفصيح المتمثل باليومي الخارج عن نسقية النظام ، فنظرت في المهمش و المقصي غير المدون إذ جرى النظر إليه في ضوء اللسانيات الاجتماعية ولسانيات التلفظ وفي ضوء فاعلية العلامة السيمائية في بنية الخطاب ، وتكللت تلك النظرات وانصهرت في المنهج النقدي لتحليل الخطاب لـ (نورمان فيركلوف ) الذي يُعنى بدراسة سلطة الخطاب واستراتيجياته في الهيمنة كما يدرس هذا المنهج الخطابات النقدية بوصفها خطابات تحررية خارجة عن تلك السلطة وتحاول الانعتاق من هيمنتها . كما ان المنعطف التَّداولي الحديث نحو السَّرد والمعالجات اللسانيَّة الإدراكيَّة تمخَّضت عن إفراز وتدشين رؤى منهجية متطورة تمثلت بالتَّداوليَّة السَّردية في بحثها للواسمات اللفظية داخل نسيج السَّرد المشكل للهوية الجمعية استئناساً بمقولات المفكر الفرنسي ( بول ريكور ) . فالشعبي هو خطاب مهمش ويومي موازنة بالخطاب النخبوي فيمكن أنْ يُدْرَسَ في ضوء النظر البينيّ في لسانيات تحليل الخِطَابِ . إنَّ أنماط المتن الشعبي يمكن رصدها في الأنماط اللغوية الآتية التي يمكنها أن تعيد تكوين هذا المتن الغائب عن الاهتمام ، إذ يبرز نمطه الأول في النصوص المهاجرة من الرسمي والمستوطنة في الشعبي إذ إيثار التدين الشعبي لنصوص رسمية دون غيرها إنَّما يمثل حاجة نفسية واجتماعية تشكل خصوصيته وهويته المفارقة ، فقد تغادر هذه النصوص وتهاجر إلى الفضاء الشعبي كبعض مدونات قصص الأنبياء وأحاديث الثواب والنعيم وعذاب القبر وأهوال البرزخ والقيامة وأخبار الملاحم والفتن المتعلقة بأنباء آخر الزمان وتفسير الأحلام وحكايات المتصوفة وكرامات الأولياء ومناقبهم وكتب الأذكار والأدعية ويتم تبيئتها في الفضاء الشعبي بينما هناك نصوص رسمية تمثل المركز والصدارة في التدين الرسمي مثل الكتب الفقهية وكتب التفسير ومدونات علم الأخلاق وتهذيب السلوك لا يَهتم بها كثيراً التدينُ الشعبي ، وكذلك كتبُ علم الكلام والعقائد بجوانبها الاستدلالية النظرية ، فهي بعيدة عن المزاج الشعبي ، وتحضر بدلاً منها كتب النزاعات المذهبية التي تُحرِّضُ على الكراهية وازدراء الآخر . ومعظم تلك المدونات يتخذ منها الخطاب الديني الرسمي موقفاً سلبياً ناقداً لأنَّ روافدَها ومرجعياتِها تمثلت بالمرويات الاسرائيلية والأحاديث المرسلة والضعيفة . وكأنَّ تلك المرويات بما تختزن من مُدهش ومفارق وخارق تمثل مرآة سردية لفهم الذات الشعبية لنفسها ، فالسَّردُ بما يمثل من نسيج ملتحم تأتلف به الأضداد والوقائع المختلفة والشخصيات المتباينة في أبعادها الزمانية والمكانية فيتحقق فيه انسجامُ عناصره ضمن مفهوم الحبكة التي تبيح لتلك الأشتات الائتلاف في ثنائيات الخير والشر، فالآخر يمثل ضرورة مهمة لتشكل الأنا في بنية السَّرد ، والإمعان بشيطنته مذهبياً سوف يغذي الكراهيَّة و يحقق الشعورَ بالطمأنينة العقائدية وكون الذات على حق والآخر على ضلال فيخفف من حدة قلقها النرجسي ، فلا نعجب بعد هذا إذا وجدنا الكتب التي تتحدث عن رحلة المتحولين دينياً ومذهبياً تشكل عنصراً مشوقاً وفاعلاً ومؤثراً في تلقيات الذائقة الشعبية الدينية ، إذ لم تكن الدواعي نحو التحول دواعي عقائدية صرف ناجمة عن قلق روحي محض بل ربما كان معظمها تحت وطأة قهر اجتماعي أو نفسي يمر به المتحول نفسه من داخل عقيدته الأولى فيكون تحوله انتقاماً و خروجاً على سلطة قهرية الأمر الذي يذكي الإحساس بالهوية عند القارئ وتمايز الآخر المختلف عنه مذهبياً فيشكل له هذا اللون من الكتابة خياراً مهما في القراءة . والنمط الثاني الذي يسهم في تكون هذا المتن هو ( السرد الشعبي) إذ هناك سرد شعبي يتناص تناصاً خارجياً مع السرديات الرسمية المؤسسة ولكن تهيمن فيه النزعة الأسطورية وتغلب فيه سيمياء الأهواء في نظرها للشخصيات الدينية في حين النصوص الرسمية ولا سيما الفقهية منها هي نصوص في درجة الصفر من الكتابة بمفهوم (بارت) بمعنى تغيب هيمنة الذات المنشئة للنص ويغلب فيها العنصر الإعلامي الإخباري في نقل رأي الدين في وقائع وحوادث وأحكام فقهية ، فهي تحرص على الموضوعية في النقل على خلاف النصوص الشعبية. و تشكل الأمثال الشعبية الدارجة نمطاً مهماً يسهم في تكون المتن اللغوي ، فالأمثال أكثر الأشكال اللغوية قدرة على فحص الحسّ العقائدي الشعبي ، فهي إحدى مكونات العقل الشعبي فهي ــ في الغالب ــ تظهر في الخطاب الحجاجي أو الخطاب التوجيهي لقدرتها الإقناعية وإذعان العامة لسلطتها وما تختزن من تجارب جمعية و هي تمتاح من ذاكرة مفهومية شعبية مؤسسة لواقعة المثل وسرديته ، وكثير من الأمثال تمثل احتجاجاً على الشريعة وتصوراتها ، و قسم منها يجسد التصورات الاعتقادية المؤمنة مما يعكس تناقضاً وازدواجاً في الرؤية ، كما إن توظيف المثل في الكلام يصون المرءَ وضاربَ المثل من التبعات التي تتجرأ على الشريعة ، فهو مثل متداول ومسكوك وليس من إنشائه ، فالتضمين والتناص الصريح كالأمثال في أيِّ نصّ من النصوص واحدة من أهم وظائفه التبرؤ من تبعات الفكرة المتضمنة وإسنادها لغير منشئ الخطاب وإنْ كان معتقداً بها . وتمثل الرسائل التي تُلقى في المراقد وأضرحة الأولياء ومراقد الصالحين أهم أشكال المتن اللغوي الشَّعبي المدون ، ويُمكن النظرُ إليها في ضوء الأسلوبية التعبيرية ، فهي نصوص مليئة بالجمل الإفصاحية الإنشائية غير الإخبارية أي إنَّها تعبر عن تجارب وجدانية مؤلمة وحزينة وانكسارات يعجز عن حلها الإنسان ، فهي تتضمن التوسلَّ وطلب الشفاعة في قضاء الحوائج وتصوراً إيماناً عميقاً بالقدرية واعتقاداً راسخاً بقدرة الولي على الشفاعة وقضاء الحوائج بما يصل إلى حدِّ الغلو ، فهي أفعال إنجازية لغوية تعبيرية ترتكز على التوسل ، و إنجازيتها في ضوء تصور أوستن تلبي الإحساس بالشعور بالأمان والطمأنينة إزاء قلق متنام بسبب عجز الذات المتوسلة عن حلِّ المشاكل التي تواجهها بنفسها كشفاء مرض أو ضيق في رزق أو مشكلة أسرية ، وقسم منها يتضمن عنفاً لغوياً في ألفاظه النفسية المشحونة بانفعالات الغضب وطلب إنزال السخط والانتقام من أشخاص صدرت منهم ظلامات تجاه صاحب الرسالة . وكان عالم الاجتماع المصري (سيد عويس) قد درس اجتماعياً ونفسياً الرسائل الملقاة في مرقد الإمام الشافعي في مصر ، وهي دراسة مميزة لم يسبق اليها أحدٌ من الباحثين بيد أنها لم تولِ الجوانب اللغوية أهمية ، ولم توظف المناهج اللسانية أو النقدية في تحليل مضمونها بسبب اقتصار نظرها على الجوانب الاجتماعية فحسب .
ويُنْتَهَكُ المقدسُ والدين في انفعالات الغضب وما يصاحبها من عبارات سَبٍّ وشتم للمقدسات وكأنَّ الذي يُصرِّح بعبارات الكفر والجحود يبارزُ المجتمعَ بنقضه للقيم التي يؤمن بها فيثور عليها غضباً ونزقاً ، وغالباً ما يحدث ذلك في لحظات الشّجار وفي يأس وإحباط و وقاحة و استهانة مفرطة في خرق المحظور اللغوي والقيمي الديني ، فالسب مثال لخرق قاعدة الأدب الاجتماعي في الحوار ، وفي ضوء اللسانيات الإدراكية وتصور (جورج لايكوف) عن الاستعارات التصورية التواضعية فإنَّ أغلب ألفاظ الكفر هي استعارات تصورية يكون فيها حقل المدنس مجالاً تصورياً مصدراً من خلاله يتمثل المقدَّسُ ، فهناك سمات انتقائية في حقل المُدَنَّسِ يجري تبئيرها وتنشيطها وإسقاطها على المجال التصوري الهدف ، وهذه السمات تمثل أعلى درجات الانحطاط القيمي في حقل المدنس إذ يتم أنسنة الذات الالهية المقدسة ونعتها بأخس الرذائل التي تسقط الإنسان من عين الإنسان الآخر مما يتبادله الأفراد في شتم بعضهم للآخر . وهذه العبارات التي تنتهك المقدس تأذن بانتهاء السجال وغلق المحاورة ، فهي تمثل أعلى نوبات الغضب وانفعالاته ، فالآخر سيعزف عن محادثة من يسب المقدس خشية السخط الالهي ، وعلى ضوء مفهوم( قاعدة الوجه في التداولية ) يمثل شتم المقدس هجوماً وعنفاً تجاه الآخر و تهديداً لوجهه الاجتماعي ومنزلته الاعتبارية في الحوار . وفي هذه الوقائع اللغوية يتقابل خطابان هما خطاب السب وخطاب الاستغفار والحوقلة، وهذا الأخير يتبرأ من فعل الأول خشية السخط الإلهي ويتضمن احتجاجاً مباشراً ورفضاً له.
وفي ضوء المنهج النقدي لتحليل الخطاب يمكن أن تُعَدَّ النكاتُ خطاباً تحررياً مناهضاً لسلطة فوقية إذ تتضمن النكات والطرائف سخرية شديدة من المقدس وتهكماً لاذعاً قد يشمل الذات الالهية المقدسة والأنبياء والملائكة ومؤسسي المذاهب ورموزه ، فهي مرآة للصراع المذهبي والخروج على المقدس ونقده ، وهي متنفس للمكبوت والمقموع في اللاشعور الجمعي ، وهي إحدى أهم الوسائل للكشف عن اللاشعور مثل الأحلام وزلات اللسان من منظور فرويد ، فالنكتة هي المجال الوحيد الذي يخرق المحظور ويكون الخرق مقبولاً لأنه في سياق تندر ولا يشملُ الأمرُ المحظورَ الدينيّ فحسب بل حتى المحظور الجنسي أيضاً ، وتخفف النكتة من حرج الراوي لها في جرأته على انتهاك المعتقد أو المحظور ، فهو راو ينقل ويحكي ما ليس له من قول (فناقل الكفر ليس بكافر) كما يتردد شعبياً ، وتتشابه هذه السمة مع الأمثال ، فهي نصوص متداخلة تتيح لراويها أن يبرأ من تبعاتها.
وفي تسمية الشخصيات والرموز الدينية غالباً ما يلجأ العقل الشعبي إلى توليد أسماء غير الأسماء والألقاب التي ينتهجها الخطابُ الدينيّ الرسميّ ، فالكثير من الأولياء يُستعاض عن ألقابهم وأسمائهم التاريخية ويُعبَّر عنهم بحادثة أو واقعة ظهرت فيها كراماتهم ، وهذه الحادثة تجسد اليقين الشعبي من خلال سردية يؤمن بها وتشكل يقينه وهويته الدينية . كما ان الكثير من الأفعال الإنجازية اللغوية من دعوات وتبريكات التي ترافق الطقوس الدينية أو طقوس العبور من ولادة وزواج ومواساة وتهنئة على أداء فرض من صيام أو حج هي بحسب (أوستن) ونظريته الانجازية أفعال شعورية إفصاحية تعبر عن النواحي الوجدانية وتضطلع بوظيفة إقامة التواصل والمجاملة وتعزز روحَ التضامنِ بين الجماعة الواحدة وتعملُ على تمتين هويتهم الدينية ، ويمكن تصنيفها بأنها جزء من أفعال الهوية اللغوية حسب تصور اللساني الأمريكي ( وليم لابوف) .
وكلُّ ما تقدم من أنماط تعبيريَّة شعبيَّة بوسعها أنْ تعيدَ تكوينَ المتن اللغويّ الغائبِ عن دائرة الاهتمام وأن ترسم حقيقةَ التدين الشعبي التي يلوح فيها الإيمان والتسامح والقدرية إلى جنب ازدراء الآخر والغلو في الأولياء والجرأة على الذات الالهية والتسليم المطلق والاستغراق في الأساطير على حد سواء ، ويلوح منها العنف اللغوي في الابتهال لإنزال اللعنات على الآخر ، فهو معتقد يجمع المتنافرات والمفارقات ، كلُّ ذلك يدعو إلى إعادة النَّظر في الصورة الزاهية والمتسامحة التي ترسمها المناهجُ الاجتماعية والنفسية والأنثروبولوجية إذ تبدو صورة المعتقد الشعبي من خلال مفهوم المتن اللغوي ولسانيات تحليل الخطاب صورةً مغايرةً تغيب فيها العقلانية وترفض قبول الآخر ، كما يدعو أيضاً ما تقدم من تحليل إلى إعادة النظر في مفهوم وحدة العقل الشعبي الديني وانسجامه، ففي فحص المتن اللغوي لا تسلم هذه النظرية (وحدة العقل) من النقد الشَّديد الأمر الذي يبرهن على فاعلية النظر اللسانيّ البينيّ المرتكز على مفهوم تحليل الخطاب ونقده في تجلية هذه الصورة المفارقة عن ما تبنته معظم الدراسات حول التدين الشعبي.


 الإطاحة بتجّار ومروّجي مخدّرات في الأنبار
الإطاحة بتجّار ومروّجي مخدّرات في الأنبار
 هل بقت ثوابت في البلد؟
هل بقت ثوابت في البلد؟
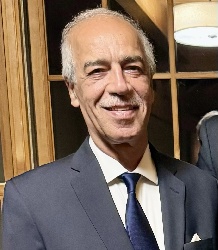 لماذا نجح الكرد وفشل العرب في العراق الجديد؟
لماذا نجح الكرد وفشل العرب في العراق الجديد؟
 بوقت قياسي القبض على متهمين بقتل شاب في العمارة
بوقت قياسي القبض على متهمين بقتل شاب في العمارة
 العراق ينفتح على شل لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة
العراق ينفتح على شل لتنفيذ مشاريع كبرى في قطاع الطاقة
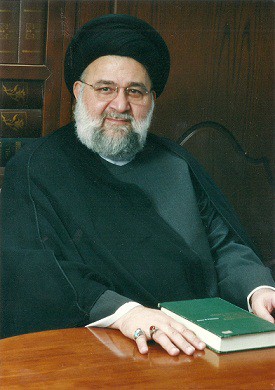 الرسول (ص) يسلط الأضواء على ما سيشهده المستقبل من ظواهر إنحرافيه
الرسول (ص) يسلط الأضواء على ما سيشهده المستقبل من ظواهر إنحرافيه
 غراهام: على الجميع الإيمان بقدرات الوطني في التأهل والإستعداد الأمثل هو الفيصل
غراهام: على الجميع الإيمان بقدرات الوطني في التأهل والإستعداد الأمثل هو الفيصل
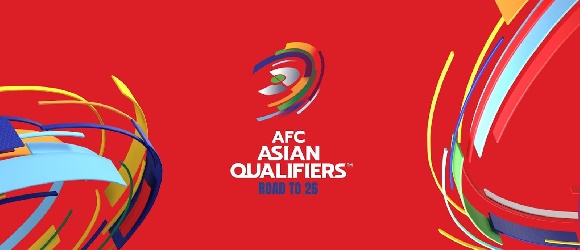 قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 في كوالالمبور الخميس المقبل
قرعة الملحق الآسيوي المؤهل لمونديال 2026 في كوالالمبور الخميس المقبل
