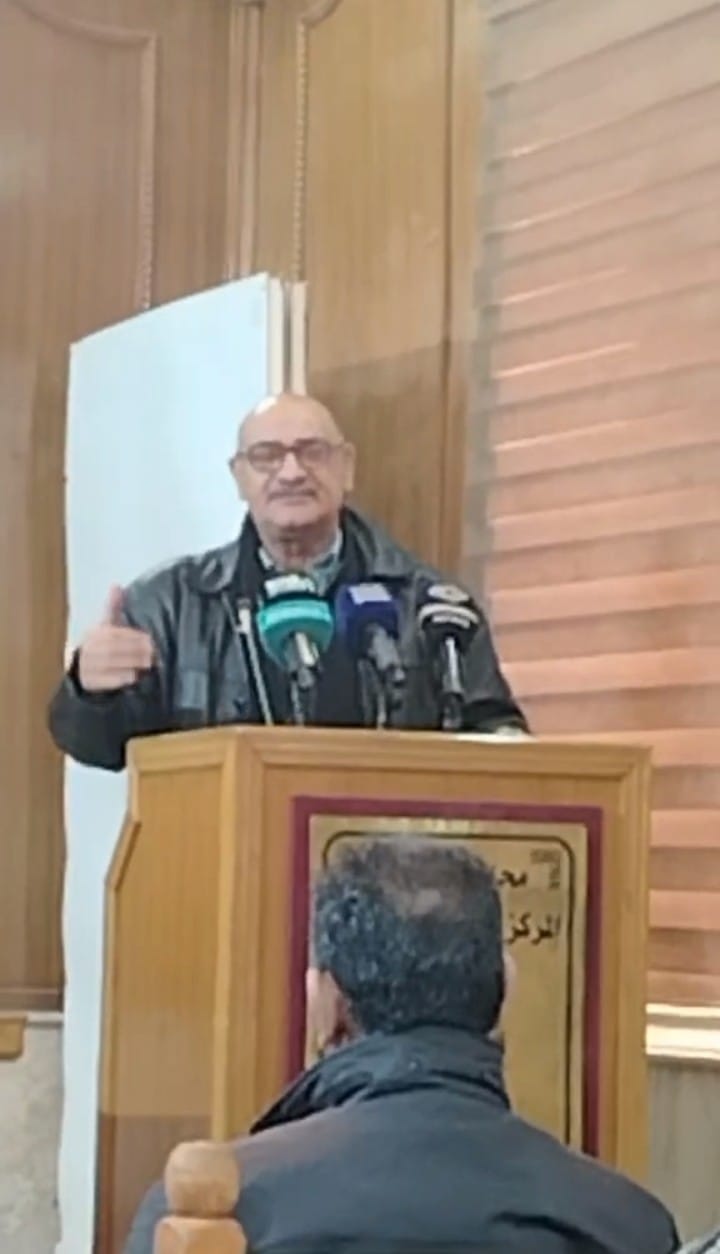


الواقعية في الرواية العراقية: بين الوهم التمثيلي وحدود «أدب المرحلة»
حمدي العطار
مداخلة نقدية
حين نتحدث عن «الواقعية» في الرواية، فإننا غالبا ما نكرر مصطلحا مستهلكا أكثر مما نمارس مفهوما نقديا دقيقا. إذ جرى، في التداول الثقافي العربي، الخلط بين الواقعية بوصفها منهجا فنيا، وبين الواقع بوصفه مادة خام، حتى صار ينظر إلى الرواية الواقعية على أنها «عمل حقيقي» لا «عمل فني»، وهو خلط أضر بالسرد أكثر مما خدمه.
فالواقعية ليست نقلا فوتوغرافيا للواقع، ولا تسجيلا محايدا للأحداث، بل هي موقف فكري وجمالي من العالم، يقوم على إعادة تشكيل الواقع لا نسخه. وكل رواية تكتفي بعكس الوقائع كما هي، دون مساءلة أو تفكيك، لا تنتج أدبا، بل أرشيفا.
في التجربة العراقية تحديدا، انزلقت الواقعية في كثير من الأحيان إلى ما يمكن تسميته بـ«أدب المرحلة». فقد أُغرقت الساحة بروایات وقصص كتبت تحت ضغط الحدث، ولا سيما الحروب والمعارك، فبدت النصوص أسيرة زمنها، عاجزة عن تجاوزه. ومع انتهاء المرحلة، انتهت معها أغلب هذه الأعمال، لأنها لم تنتج رؤية، بل استهلكت الحدث.
ومع أن بدايات القرن العشرين شهدت محاولات واقعية مبكرة، كما في أعمال محمود احمد السيد وذنون أيوب و عبد الحق فاضل واحد خالص الشعلان، فإن الرواية العراقية لم تبلغ نضجها الواقعي الاجتماعي إلا مع صدور رواية «النخلة والجيران» لغائب طعمة فرمان عام 1965. هنا فقط بدأ الواقع يرى من زاوية اجتماعية نقدية، لا بوصفه خلفية للأحداث، بل بوصفه بنية قمعية تنتج مصائر الشخصيات.
التحول الأعمق جاء لاحقا مع رواية «الرجع البعيد» لفؤاد التكرلي، حيث انتقلت الواقعية من توصيف الخارج إلى تفكيك الداخل النفسي، لتصبح الشخصية مركز الصراع لا مجرد أداة سردية. ومع ذلك، فإن هذا التطور ظل محكوما بسقف الواقعية، دون كسر جذري للبنية الزمنية أو السردية.
أما رواية «خمسة أصوات» لغائب طعمة فرمان، فقدمت اختبارا مهما لتعدد الأصوات، لكنها بقيت – رغم هذا التجريب المحدود – أسيرة الواقعية السياسية. فالتعدد الصوتي لم يتحول إلى تفكيك حقيقي للزمن أو إلى مساءلة جذرية للحقيقة، بل ظل ضمن سرد خطي حذر، واسترجاع محدود، وكأن النص يخشى القفز الكامل نحو الحداثة.
وإذا انتقلنا إلى التصنيف الأوسع لأساليب كتابة الرواية، أمكن اختزالها – دون تبسيط مخل – في ثلاثة أطر كبرى:
أولًا: الواقعية في القرن التاسع عشر، حيث السرد الخطي، والحقيقة الواحدة، والنهايات المتوقعة.
ثانيًا: الحداثة في مطلع القرن العشرين، حيث تحطمت خطية الزمن، وتعددت الحقائق، وصارت النهاية سؤالا لا جوابا.
ثالثًا: ما بعد الحداثة بعد الحرب العالمية الثانية، وهي مرحلة التشكيك والسخرية، وتفكيك التاريخ، واللعب السردي، والميتاسرد، بما يضع القارئ عمدا في حالة لا يقين.
غير أن الإشكالية الكبرى تكمن في أن كثيرا من الروايات العربية، حتى تلك التي تصنف ضمن الأنواع الفرعية كالبوليسية أو الفانتازية أو الغرائبية، لم تغادر فعليا مربع الواقعية التقليدية، واكتفت بتغيير القناع دون تغيير البنية. فالتجريب الشكلي وحده لا يصنع حداثة، كما أن غرابة الموضوع لا تعني بالضرورة جرأة فنية.
وفي هذا السياق، يجدر التمييز بين «الرواية الواقعية» و«الرواية الكلاسيكية». فالكلاسيكية ليست مرحلة زمنية، بل صفة تمنح للنصوص التي استطاعت تجاوز سياقها التاريخي، وامتلكت قدرة دائمة على إعادة القراءة. وكل نص يبقى حبيس مرحلته، مهما بلغت صدقيته الواقعية، يظل نصا مؤقتا.
خلاصة القول:
إن المشكلة ليست في الواقعية بوصفها خيارا فنيا، بل في تحويلها إلى ذريعة للكسل الجمالي. فالرواية التي لا تجرؤ على مساءلة واقعها، ولا تفكك بنيته، ولا تشكك في مسلّماته، لن تنقذها تسمية «الواقعية». وحدها الرواية التي تحول الواقع إلى سؤال مفتوح، هي القادرة على البقاء.


 نفي دعوة المتقاعدين لتحديث بياناتهم
نفي دعوة المتقاعدين لتحديث بياناتهم
 حزب إيراني كردي معارض يتّهم طهران بقصف مقرّه في شمال العراق
حزب إيراني كردي معارض يتّهم طهران بقصف مقرّه في شمال العراق
 قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان
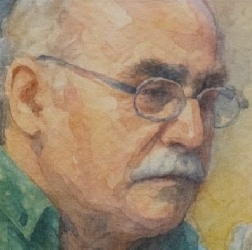 تأملات في الحرب بعصر الاتصال
تأملات في الحرب بعصر الاتصال
 تأهيل طرق حيوية في المدائن ضمن خطط تحسين الخدمات
تأهيل طرق حيوية في المدائن ضمن خطط تحسين الخدمات
 تأمين قروض مصرفية لمنح التدريسيين وحدات سكنية
تأمين قروض مصرفية لمنح التدريسيين وحدات سكنية
 وقفة عرفان في عام جديد
وقفة عرفان في عام جديد
 الحليم تكفيه الإشارة
الحليم تكفيه الإشارة
