
بين المجمع المغلق والحوزة المفتوحة: تأمل في فلسفة اختيار القيادة الدينية بين الفاتيكان والنجف
محمد علي الحيدري
في عالمٍ تتقاطع فيه اللاهوتيات مع السياسة، وتتمازج فيه أنماط السلطة الروحية مع البنى الاجتماعية، تبرز لحظتان مفصليتان في التاريخ الديني المعاصر: انتخاب بابا الفاتيكان، واختيار المرجع الأعلى للشيعة الإمامية. كلتاهما لحظتان تتجاوزان حدود الأشخاص إلى ما يمثّلونه من رمزية روحية، ومكانة معرفية، وتأثير يتخطى حدود الطائفة والجغرافيا.
في الكنيسة الكاثوليكية، يتجلّى مفهوم القيادة الدينية في شخصية البابا، خليفة القديس بطرس، الذي يُنتخب من قبل مجمع الكرادلة ضمن نظام كنسي محكم، يتّبع طقوسًا متوارثة منذ قرون. يتم الاختيار داخل “الكونكلاف” – ذلك الاجتماع السري المغلق الذي تُحجب فيه أصوات العالم خلف جدران الفاتيكان، وينحصر القرار في اقتراع سرّي يتكرر إلى أن يتوافق الثلثان على اسم بعينه. اللحظة التي يتصاعد فيها الدخان الأبيض من مدخنة كنيسة سيستينا، لا تمثّل فقط إعلان اسم الفائز، بل لحظة ميلاد رمزي لسلطة عليا يُنظر إليها كاختيار للعناية الإلهية نفسها.
أما المرجعية العليا في الحوزة الشيعية، فتتكوّن ضمن سياق مختلف جذرياً. لا مجمع انتخابي، ولا أصوات، ولا لحظة تتويج. إنما تتشكّل سلطة المرجع الأعلى من نسيج متداخل من المعرفة الفقهية، والزهد العملي، وسمعة طويلة في مضمار الاجتهاد، يضاف إليها إدراك جماعي من قبل “أهل الخبرة” بأن فلانًا هو الأعلم، الأورع، الأقدر على تمثيل الثقل العلمي والروحي للمدرسة الإمامية. الحوزة العلمية لا تصنع القائد في لحظة، بل تنسجه على مهل، عبر عقود من التراكم، والصبر، والاختبار الصامت.
وهنا تتجلّى المفارقة الفلسفية العميقة: البابا يُنتخب، والمرجع يُتّبع. الأول يُختار بتصويت رسمي داخل نظام مؤسسي مغلق، والثاني يظهر عبر تشخيص تدريجي في فضاء علمي واجتماعي مفتوح. في الفاتيكان، تصنع المؤسسة رأس الكنيسة وتمنحه شرعية القيادة؛ أما في الحوزة، فإن رأس المرجعية يفرض حضوره، ويعيد تشكيل المؤسسة من حوله. السلطة هنا تُمنح من نخبة كنسية تمثّل بنية النظام، وهناك تُكتسب من جماعة خبراء تمثّل سعة المجال.
كذلك تختلف طبيعة السلطة بعد الاختيار. البابا يجمع بين سلطة روحية وأخرى زمنية، بصفته رأس الكنيسة الكاثوليكية ورئيس دولة الفاتيكان ذات السيادة. أما المرجع الأعلى، فرغم غياب أي منصب رسمي، إلا أن سلطته المعنوية تمتد في ضمير الملايين من أتباعه، وتؤثر في خياراتهم الدينية والاجتماعية والسياسية، لا عبر أوامر نافذة، بل من خلال فتوى يُنظر إليها كحجّة شرعية واجبة الاتّباع. الكنيسة تتكئ على مؤسسات بيروقراطية وتنظيم هرمي، بينما تستند المرجعية إلى شرعية علمية وأخلاقية متجذّرة في علاقة خاصة بين العالم والنص، وبين المرجع وجمهوره.
إن البابوية، في بنيتها وآلياتها، تمثل نموذجًا كلاسيكيًا للسلطة الكنسية المركزية، القائمة على التراتبية والانضباط المؤسسي. أما المرجعية، فتمثل نموذجًا فريدًا لسلطة دينية لامركزية، تتكوّن تدريجيًا، وتستند إلى تقليد علمي وتاريخي مستمر، لا تحدّه بنية إدارية ولا يقرّره مرسوم. كلا النموذجين يعكسان في النهاية رؤيتين مختلفتين لطبيعة القيادة الدينية، ومصادر شرعيتها، وآليات إنتاجها، والتوازن بين التاريخ والنص، بين المؤسسة والفرد، بين الإرادة الجمعية والإلهام الشخصي.
وهكذا، فإن المقارنة بين البابا والمرجع الأعلى ليست مجرد مقارنة بين شخصين، بل بين فلسفتين كاملتين في إدارة الشأن الروحي: إحداهما تخلق القائد ضمن لحظة حاسمة، والأخرى تدع القائد يتشكّل بصمت، إلى أن تفرضه القناعة وتكرّسه الجماعة.


 الشرطة تخسر من تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا
الشرطة تخسر من تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا
 إطلاق الإعانة الإجتماعية لاكثر من مليوني مستفيد
إطلاق الإعانة الإجتماعية لاكثر من مليوني مستفيد
 رشيد يصل إلى الدوحة للمشاركة في قمة التنمية
رشيد يصل إلى الدوحة للمشاركة في قمة التنمية
 اتفاقية المياة بين العراق وتركيا
اتفاقية المياة بين العراق وتركيا
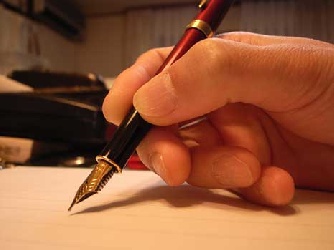 محمد الحسان.. صوت الأمم المتحدة الهادئ في بغداد
محمد الحسان.. صوت الأمم المتحدة الهادئ في بغداد
 التقنيات الفنية والاسلوبية ودورًها في إنزياح المعنى
التقنيات الفنية والاسلوبية ودورًها في إنزياح المعنى
 السيّاب في حضرة الحياة
السيّاب في حضرة الحياة
 مجاز الضوء بلاغة التشكيل وإنبعاث الدلالة في شعر رشيد ياسين
مجاز الضوء بلاغة التشكيل وإنبعاث الدلالة في شعر رشيد ياسين
