
الدولة الحضارية الحديثة في مرآة النماذج السياسية: قراءة مقارنة
محمد عبد الجبار الشبوط
المقدمة
ظلّت مسألة الدولة من أهم قضايا الفكر السياسي منذ نشأته الأولى. فقد انشغل الفلاسفة والمفكرون منذ أفلاطون وأرسطو إلى هوبز ولوك وروسو وماركس والصدر، بمسألة الكيان السياسي الأمثل الذي ينظم حياة البشر. ومع دخول البشرية إلى العصر الحديث تبلور نموذج “الدولة الحديثة” بعد معاهدة وستفاليا ( 1648 )، ثم ظهر نموذج “الدولة الديمقراطية” في الغرب، ونموذج “الدولة التنموية” في شرق آسيا. غير أن هذه النماذج جميعًا، برغم نجاحاتها الجزئية، لم تقدّم إطارًا تكامليًا يربط بين الإنسان والقيم والتاريخ والاقتصاد والسياسة في وحدة نظرية متسقة.
من هنا تنبثق الحاجة إلى الدولة الحضارية الحديثة (د.ح.ح)، التي تقترح رؤية شاملة تنطلق من “المركب الحضاري” المكوّن من خمسة عناصر: الإنسان، الأرض، الزمن، العلم، والعمل، وترتكز على منظومة القيم العليا التي توازن بين البعد الروحي والبعد المادي، وبين الحقوق والواجبات، وبين الحرية والمسؤولية.
في المصطلح: "الدولة الحضارية"
يذهب بعض الباحثين إلى القول إن مصطلح “الدولة الحضارية” لا وجود له في الفكر السياسي. لكن هذا الزعم غير دقيق، إذ نجد في الأدبيات المعاصرة استخدامات متزايدة لتعبيرات قريبة من هذا المفهوم:
في الأدبيات الصينية ظهر مصطلح文明型国家 (civilizational state) • مع كتابات المفكر تشانغ وي وي (Zhang Weiwei) الذي وصف الصين بأنها “دولة حضارية” تمتد جذورها آلاف ، السنين، وليست مجرد نسخة من الدولة–الأمة الأوروبية.
في الكتابات الإنجليزية يتكرر استخدام civilization-state أو civilizational state خصوصًا في النقاشات حول الصين والهند وروسيا، حيث يُراد التأكيد على أن هذه الكيانات لا تُختزل في مفهوم “الدولة الوطنية” بل تستند إلى إرث حضاري متواصل.
• بعض المفكرين الروس (مثل ألكسندر دوغين) استعملوا وصف “الحضارة–الدولة” للدلالة على خصوصية روسيا في التاريخ الحديث.
الجديد في مفهوم الدولة الحضارية الحديثة (د.ح.ح) أنني لا اكتفي باستخدام المصطلح توصيفًا لحالات بعينها (الصين، روسيا)، بل اعيد صياغته كإطار نظري كوني يصلح لتفسير الواقع واستشراف المستقبل. كما أن إضافة كلمة “الحديثة” تضع المشروع في صميم مكتسبات العصر، وتمنحه بعدًا عالميًا لا يقتصر على دولة بعينها. والأهم من ذلك انني اربط المصطلح بمفهوم “المركب الحضاري” ومنظومة القيم العليا، وهو ما يجعله أكثر شمولية وعمقًا من أي استعمال آخر.
النموذج الأول: الدولة الحديثة
نشأت الدولة الحديثة في أوروبا بعد معاهدة وستفاليا ( 1648 ) التي أنهت الحروب الدينية وأرست مبدأ سيادة الدولة داخل حدودها الجغرافية.
• الخصائص: السيادة المطلقة، الحدود المعترف بها، القانون المركزي، البيروقراطية.
• نقاط القوة: إرساء النظام الدولي، بسط سلطة القانون، إنهاء الفوضى السياسية.
• نقاط الضعف: غياب البعد القيمي والإنساني، اختزال الدولة في أداة للسلطة.
النموذج الثاني: الدولة الديمقراطية
ارتبطت نشأتها بالفكر التنويري والعقد الاجتماعي.
• الخصائص: الانتخابات، سيادة الشعب، التعددية الحزبية، حرية التعبير.
• نقاط القوة: ترسيخ الحرية، ضمان مشاركة المواطنين، حماية الحقوق.
• نقاط الضعف: قد تنزلق إلى “استبداد الأغلبية”، وإلى هيمنة رأس المال على السياسة، مع إهمال القيم العليا لصالح الصراع السياسي.
النموذج الثالث: الدولة التنموية
تبلور هذا النموذج في شرق آسيا (اليابان، كوريا الجنوبية، سنغافورة، ماليزيا).
• الخصائص: تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد، التخطيط طويل الأمد، سياسات صناعية نشطة.
• نقاط القوة: إنجازات اقتصادية لافتة، نقل شعوب فقيرة إلى مصاف الدول الصناعية.
• نقاط الضعف: التركيز المفرط على النمو المادي، ضعف المشاركة الديمقراطية، إغفال البعد القيمي.
النموذج الرابع: الدولة الحضارية الحديثة (د.ح.ح)
• الأساس النظري: المركب الحضاري (الإنسان، الأرض، الزمن، العلم، العمل).
• المنظور القيمي: العدل، الكرامة، الحرية المسؤولة، الكفاية، الرحمة.
• الخصائص:
1. اقتصاد حضاري يقوم على مبدأي العمل والحاجة، وعلى التوزيع العادل للثروة.
2. سياسة مؤسساتية تعتمد الديمقراطية التداولية لا مجرد الانتخابات الشكلية.
3. مواطنة فعّالة تعني الإنسان المنتج، الصالح، الواعي.
4. مجتمع حضاري يعيد التوازن بين الفرد والجماعة، وبين الإنسان والطبيعة.
5. رؤية زمنية بعيدة المدى تربط الحاضر بالماضي والمستقبل، وتستوعب بعد الغاية الإنسانية.
• نقاط القوة: شمولية وتكامل، إدماج القيم في السياسة والاقتصاد، تقديم بديل واقعي لمجتمعات تبحث عن النهضة.
• التحديات: غياب التطبيق العملي، الحاجة إلى تبني النخب وصنّاع القرار لهذا النموذج.
المقارنة النقدية
• الدولة الحديثة ركزت على السيادة والقانون لكنها تجاهلت الإنسان والقيم.
• الدولة الديمقراطية وسّعت دائرة المشاركة لكنها قدّمت حرية من دون مسؤولية قيمية.
• الدولة التنموية حققت النمو لكنها أهملت العدالة والمواطنة.
• أما الدولة الحضارية الحديثة فتسعى إلى تكامل هذه الأبعاد: سلطة قانونية، مشاركة سياسية، نمو
اقتصادي، ومجتمع قيمي، ضمن إطار حضاري جامع.
الخاتمة
إن الدولة الحضارية الحديثة ليست مجرد تطوير لأحد النماذج السابقة، بل هي إعادة تأسيس لمفهوم الدولة على أسس حضارية شاملة. فهي تستوعب مكتسبات الدولة الحديثة، والديمقراطية، والتنموية، لكنها تتجاوزها بإدخال البعد القيمي الحضاري، وربط السياسة بالاقتصاد بالمعرفة بالزمن في إطار إنساني شامل.
بهذا المعنى، يمكن النظر إلى د.ح.ح بوصفها مشروعًا فكريًا أصيلًا يستجيب لحاجات عالمنا العربي والإسلامي، ويقدّم في الوقت نفسه إسهامًا عالميًا في النقاش الدائر حول مستقبل الدولة بعد أن بدأت الأطر التقليدية تفقد صلاحيتها.


 حين تصير الكلمة طريقاً .. الأدب الصوفي ورحلة البحث عن المطلق
حين تصير الكلمة طريقاً .. الأدب الصوفي ورحلة البحث عن المطلق
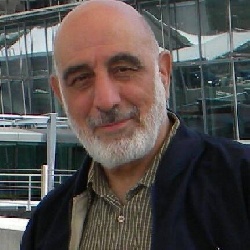 قراءة سياسية مبكرة لتطورات الوضع الإيراني
قراءة سياسية مبكرة لتطورات الوضع الإيراني
 أسراب الطيور المهاجرة تحط الرحال في هور السناف بميسان
أسراب الطيور المهاجرة تحط الرحال في هور السناف بميسان
 توقيع مذكرة تفاهم في واشنطن لتسهيل إجراءات الإبتعاث
توقيع مذكرة تفاهم في واشنطن لتسهيل إجراءات الإبتعاث
 الموانئ تحقّق إنجازاً بتخريج أول ملاك وطني في دورة المديرين
الموانئ تحقّق إنجازاً بتخريج أول ملاك وطني في دورة المديرين
 المجمع العلمي العراقي ومسؤولياته الجسام في حماية اللغة العربية
المجمع العلمي العراقي ومسؤولياته الجسام في حماية اللغة العربية
 القراءة رهان لجيل واع في المستقبل
القراءة رهان لجيل واع في المستقبل
 جدلية الوسيط الورقي والرقمي.. مقروئية الصحف في زمن البيئة التفاعلية
جدلية الوسيط الورقي والرقمي.. مقروئية الصحف في زمن البيئة التفاعلية
