


ذياب شاهين.. شاعر العبور بين القصيدة والقصيدة
محمد علي محيي الدين
في بابل، حيث تتشابك الأساطير مع الظلال، وتتنفس الكلمات عطر الطين السومري، وُلد ذياب شاهين في أول أيام تموز من عام 1957، كأن الشعر قرر أن يسري في عروقه منذ لحظة الميلاد. ومنذ ذلك الحين، ظل ابن الحلة يقتفي أثر اللغة، لا كحرفٍ يردد، بل كقدرٍ يعاش. شاعر، وناقد، وسارد، ومهندس عواطف يضبط إيقاع الشعر كما يضبط المهندس الكهرباء، وكأنه ينقل التيار من القلب إلى الورق.
لم يكن ذياب شاهين ابن مدرسة واحدة، بل كان سليل أطياف متعددة. درس الهندسة في جامعة البصرة، ثم عمل في وزارة الإسكان والتعمير، قبل أن يشد الرحال إلى الإمارات، حيث لم تنطفئ جذوة الإبداع فيه، بل توهجت أكثر فأكثر، حتى جمع بين الشهادة الأكاديمية في الإعلام، والكتابة في أبرز الصحف الثقافية في الوطن العربي، من «البيان» إلى «الخليج»، ومن «القادسية» إلى «الدستور»، ومن «الموقف الثقافي» إلى مواقع المثقف وأدب فن والنور وغيرها.
غزارة انتاج
لكن ما يميز ذياب شاهين ليس فقط تعدد نشاطاته، ولا غزارة إنتاجه الأدبي الذي تجاوز الثلاثين كتاباً في الشعر والنقد والسرد، بل تلك النبرة الخاصة التي تتسلل إلى قصائده كهمس قديم، ذلك الحزن النبيل الذي يعلو ولا ينهار، وتلك النظرة المشبعة بالتأمل والأسى، دون أن تنكسر أمام سطوة الظرف أو قسوة المنافي.
ففي دواوينه مثل «دم القمر» و*»كوليرا»* و*»بستان أزرق»* و*»ضوء يغريه سناه»* تتبدى تجربة شاعر مشغول بالتفاصيل الإنسانية، وبالعلاقة المعقدة بين الذات والوجود، وبين اللغة ومراياها. ولئن كتب الشعر العمودي والتفعيلة والنثر، فإن الثيمة التي تتكرر في أغلب أعماله هي تلك النزعة الوجدانية الممتزجة بالسخرية الرفيقة، والارتباك الجميل أمام كوارث العالم.
يرى فيه النقاد شاعرًا لا يركن إلى السكون، بل يقف على تخوم الحداثة وهو يحمل جذور التراث في قلبه. فقد قال عنه أحد النقاد الإماراتيين: «ذياب شاهين هو ابن القصيدة حين تتجاوز شكلها، وتستحيل كيانًا لغويًا يعبر عن شقاء الإنسان العربي وتمزقاته». أما الناقد العراقي حسن مطلك، فأشار إلى أن «لغة ذياب شاهين تقف في المنطقة الحرجة بين الشعر والفلسفة، يكتب وهو يتهجى العالم لا ليشرحه، بل ليعيد تسميته».
وقد أثار كتابه «العروض العربي في ضوء الرمز والنظام» اهتمام دارسي الإيقاع العربي، إذ قدّم فيه مقاربة غير تقليدية جمعت بين الحس الهندسي والتحليل الرمزي. كما شكّل كتابه «سيمياء الصورة في الصحافة الثقافية» مرجعًا في حقل النقد الإعلامي والثقافي.
ومع هذا التنوع، لم يتخلّ الشاعر عن همّه المحلي. فقد ظل يكتب عن بابل كأنها أنشودة ضائعة، وينسج من غربته جسورًا تعيد إليه رائحة نخيلها. وفي مجموعته السردية «جنائن بابل» نلمح هذا الحنين الباذخ، وهذه الرغبة في تجسيد مدينة تحتضر بالكلمات، لتبعث بالكلمات ذاتها.
مثّل الإمارات في مهرجان أصيلة النقدي، وشارك في مهرجانات المربد والبصرة وأبو ظبي، ونال شهادات تقديرية في النقد والإبداع من مؤسسات عربية مرموقة. كما أسهم في تشكيل ملامح المشهد الشعري الإماراتي من خلال كتابه «ديوان الشعر الإماراتي»، و»الشعر الإماراتي المعاصر»، الذي صار مرجعًا للمشتغلين في هذا الحقل.
إن الحديث عن ذياب شاهين ليس حديثًا عن شاعر فحسب، بل عن عقلٍ نقديّ ظل يتحرك داخل الشعر وخارجه، يقرأ ذاته ويعيد كتابتها، يرى في القصيدة سفينة نجاة في بحر الكتابة العربية، ويسعى بها إلى المرافئ الصعبة، حيث لا تنتصر إلا التجربة الأصيلة، ولا يرسو إلا الشعراء الحقيقيون.
هو الشاعر الذي عبر الأشكال، وتنوعت أصواته دون أن يفقد ملامحه، فكان ـ كما قال عنه أحد القراء ـ «كمن يكتب بمداد روحه، لا بالحبر وحده»
في قصيدته «كرةٌ ومرمى...»، يمارس الشاعر ذياب شاهين نوعًا من السخرية السوداء التي تتقاطع فيها صورة الوطن مع استعارته الكروية، ليطرح تساؤلاته الموجعة عن ضياع القيم واحتشاد الرموز الزائفة في زمن العروض التلفزيونية والتهريج الجماهيري.
ببنية تجريبية
تمتاز القصيدة ببنية تجريبية حرة تُراوح بين النثر الشعري والصور المتشظية، حيث تتوالد المجازات من صميم الواقع العربي، لا سيما في اختزال القضايا الوطنية في مباراة كرة قدم، يحرس فيها «المرمى» راهبٌ أعزل، ويُغدو «الحكم» أداة سلطة صمّاء لا تزن إلا بصافرتها، بينما يُجلل المعلق الحدث بصيحات أجوف من المعنى.
الكرة، وهي محور القصيدة المجازي، تُصوَّر كامرأة فاتنة، تجمع بين القداسة والدلال، بين الزنى والتقديس، بين الفرح والمأساة، لتكون تمثيلاً مكثفًا لفكرة الوطن أو الحقيقة المغتصبة. إنها «غانية»، «مغناج»، «قاتلة»، و»محبِّية»، كما لو أن الشاعر يريد القول إن المعركة الكبرى التي كانت تدور من أجل الوطن أصبحت تدور اليوم حول كرة، تُمنح لها الصلوات والدموع، وتُقدَّم لها الجماهير على مذبح المجد الإعلامي.
القصيدة ترصد هذا التهالك الجماهيري أمام لحظة زائفة من «الانتصار»، وتدين في باطنها انحدار مفهوم البطولة، حين يُصبح «البطل» من يسجل هدفًا في المرمى، لا من يدفع حياته على جبهات العدل أو الكرامة. المفارقة التي تشع من النص أن «المباراة» تحولت إلى ميتافورا رمزية لزمن سياسي واجتـــــــــماعي يقدّم فيه الهتاف بديلاً عن الموقف، والاحتفال بالأهداف بديلاً عن تحقيق الأحلام.
تستخدم القصيدة إيقاعًا داخليًا متوترًا، وجملاً قصيرة مقطعة تعكس حدة التوتر الجماعي والانفصام بين جوهر الأشياء ومظهرها. كما تحضر الثنائيات الكبرى (القداسة/الابتذال، الهتاف/اللعن، الكرة/الوطن) لترسم لوحة نقدية كثيفة عن عبثية المشهد العربي في مراياه الإعلامية الزائفة.
في النهاية، لا يُخفي ذياب شاهين حسرته من أن تكون «الكرةُ الأحدُ المتعالية»، بدلًا من الوطن، أو القضية، أو الكرامة. إنها قصيدة عن زمن اختلط فيه المقدس بالمدنس، وتحوّل فيه العقل الجمعي إلى مدرجات تهتف للفراغ وتبكي انتكاسات لا تعرف لها سببًا.


 العبور والعدم
العبور والعدم
 قمّة الأسبوع بين الجارين اللدودين وخروج حذر للزوراء بالمحترفين
قمّة الأسبوع بين الجارين اللدودين وخروج حذر للزوراء بالمحترفين
 بين المطرقة والسندان
بين المطرقة والسندان
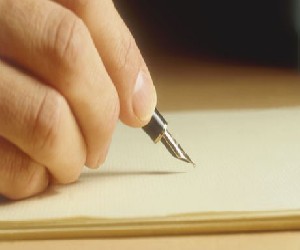 مدينة إنسانية في رفح بين الحسابات السياسية وآمال الغزيين
مدينة إنسانية في رفح بين الحسابات السياسية وآمال الغزيين
 شتان مابين ترامب و لومومبا
شتان مابين ترامب و لومومبا
 سماء العراق.. بين وفرة الرخص وشح الطائرات
سماء العراق.. بين وفرة الرخص وشح الطائرات
 العمر المفرِط بين صدق الفنّ ووهم الوقائع
العمر المفرِط بين صدق الفنّ ووهم الوقائع
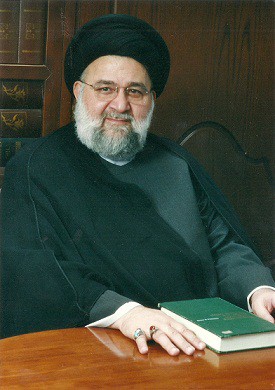 شتان بين التوبة النصوح وتوبة المفلسين
شتان بين التوبة النصوح وتوبة المفلسين
